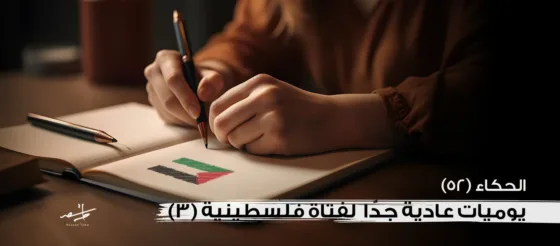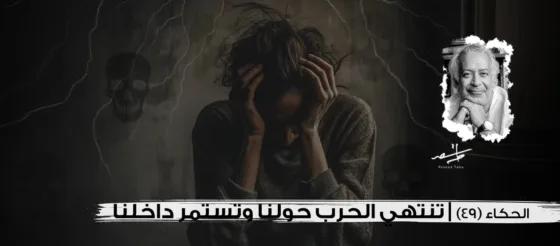(1)
ربما لو شاهدتم حكايتي فيلمًا سينمائيًّا لظننتم أن هذا لا يحدث إلا في الخيال، غير أن الحقيقة أن هذا هو ما حدث معي، أود أن أحكيه لكم؛ لعلكم تجدون فيه حكمة في هذه الدنيا العاصفة.
(2)
اسمي: آنا ماري روبرتسون، ولدتُ في العام 1860 وكنت طفلة ثالثة لعائلة تعيش في الشق الريفي من نيويورك، قبل أن نصبح -فيما بعد- عشرة أطفال، ولظروف أسرتي التحقت بمدرسة من فصل واحد مخصصة للفقراء في المقاطعة، تعلمت فيها القراءة والكتابة، غير أن أحلى ما كان فيها هو دروس الرسم.
كل ما كان يحيط بي -من خضرة وطبيعة وجمال- كان يغريني بأن أرسمه وأقلده على الورق بطريقة ما، استخدمت عصارة الليمون والعنب لألون رسوماتي، في الوقت الذي اعتاد الرسامون فيه على استخدام العشب والجير ونشارة الخشب للرسم.
لكنَّ رحلتي التعليمية -للأسف- لم تطل كثيرًا، فما أن بلغت سن الثانية عشرة من عمري، حتى طلب مني أهلي أن أنتقل لمزرعة مجاورة يمتلكها أثرياء لأعمل فيها خادمة تقوم بالشئون المنزلية مثل الطهي والتنظيف.
وظللت أتنقل بين عائلة وأخرى، حتى لاحظتْ إحداها اهتمامي بالرسم، وعدم قدرتي على شراء أدواته، فأحضروا لي الطباشير والشمع، وقد اشترطوا عليَّ ألا يؤثِّر ذلك على مهامي في العمل.
أبلغ السابعة والعشرين من عمري، أكبر ويكبر معي حلمي بالرسم، أنتقل للعمل في إحدى المزارع، وهناك ألتقي أحد العاملين، نقع في الحب ونتزوج.
يخبر أحدهم زوجي أن عمليات إعادة الإعمار في الجنوب تمثل فرصة ذهبية للحصول على عمل وكسب الكثير من المال، فلا نضيِّع وقتًا ونتوجه إلى الجنوب، تحديدًا إلى ولاية نورث كارولينا، لكننا لم نجد ما قيل لنا، تنقذنا خبرتنا بالعمل في المزارع، فحصل زوجي على وظيفة في مزرعة خيول.
(3)
ننجح في ادخار بعض المال، نشتري بقرة، ونبدأ في بيع الزبدة من حليبها، كنوع من التجارة وإضافة دخل لمدخراتنا، تقسو الحياة علينا، ولم يعد دخلنا يكفينا، إلى أن تستقر أمورنا بعد جهد كبير، ننجب عشرة أطفال يعيش منهم نصفهم.
في العام 1905 يخبرني زوجي أنه مشتاق بشدة للعودة إلى الديار، نحمل حقائبنا كالمجانين ونعود، ولأول مرة في حياتنا نتملك مزرعة، وأصبحنا -أخيرًا- ملاكًا وليس عمالاً أُجراء.
في عام 1927 يتوفى زوجي إثر أزمة قلبية، ويصبح عليَّ أن أواصل حياتي منفردة، فقررت السفر إلى مقاطعة بينينجتون لأعتني بابنتي التي تعاني من مرض السل، وهناك تعرض عليَّ قطعة من القماش مطرزة بالخيوط على شكل جمالي، وتطلب مني أن أطرِّز مثلها تمامًا، ففعلت وكانت النتيجة رائعة، لكن يدي تألمت، فاقترحتْ عليَّ أختي أن أرسم بدلاً من الخياطة والتطريز.
كان الأمر عرضيًّا لكنه أعاد لي ذكريات الماضي القديم وأحلامي بالرسم، وبالفعل رسمت عدة لوحات من وحي الطبيعة التي أحبها، وأرسلتها إلى معرض كامبريدج الريفي، وأرسلتُ معها بعض المعلبات التي أصنعها من المربى والعصير، قبلت المعلبات ولم تقبل رسوماتي!.
(4)
تمر الأيام وتشاء الأقدار أن أتلقى دعوة من جارة لي لحضور معرض التبادل النسائي الذي تنظمه، وهو معرض تشارك فيه النسوة بما يملكن من أشياء ذات قيمة للمبادلة مع الآخرين.
تحصل إحدى المشاركات على لوحاتي وتعلقها في صيدليتها، وتشاء الأقدار مرة أخرى أن يمر بالمحل أحد المهتمين بجمع الأعمال الفنية، والذي يشاهد اللوحات فيقوم بشرائها كلها، ثم يبحث عن الفنانة التي رسمتْها ويأتى لي.
يعدني الرجل بأن أصبح -وأنا الجدة- فنانة مشهورة، وأنَّ ما عليَّ سوى أن أكمل مسيرتي، اتهمه أصحابه بالجنون، لم يكترث للأمر، وفي معرضه -الذي أقامه في نفس العام- قدَّم لوحاتي لرواده، الذين ما أن عرفوا أني قد بلغت من العمر 78 عامًا حتى تجاهلوا اللوحات؛ معتقدين أن الأمر لن يكون مربحًا ولا يستحق الاستثمار فيه.
غير أن الرجل كان مصرًّا على دعمي، فكرر المحاولة، وأقنع آخر بإقامة معرض لي تحت اسم: “ما رسمته زوجة الفلاح” دون الإشارة إلى اسمي، اعتقادًا أنه لن يكون لافتًا للنظر.
يحصل المعرض على دعاية جيدة، وعلى هامشه يُجري صحفي حوارًا معي وينشره ليذكر أن اسمي هو الجدة موسى؛ نسبة للقب زوجي: توماس سالمون موسى.
يُقام معرض آخر بعدها في نيويورك وأُدعى إليه، ويحضره عدد أكبر من الصحفيين، يطلبون مني أن أُلقي كلمة، أرتبك، وكان مضحكًا ألا أجد ما أتحدث عنه سوى المربى والفواكه المحفوظة، وبقدر بساطة حديثي إلا أنه أعجب الكثيرين وقتها، واشتهرتُ بعدها، وصار الكثيرون يعرفون اسم الجدة موسى.
ثم أتتني فرصة أخرى حين عَرض عليَّ معرض سانت إتيان والمركز الأمريكي البريطاني للفنون تولي مهمة الترويج للوحاتي في مختلف الولايات بعدما كانت شهرتي مقتصرة على نيويورك فقط.
تستمر النجاحات أكثر فأكثر، وأزداد شهرة، وتُقام للوحاتي معارض متنقلة بين الولايات المختلفة، ثم لاحقًا في عشر دول أوروبية.
في العام 1949 يكرمني الرئيس الأمريكي ترومان، ثم ينتج لاحقًا فيلم وثائقي عن سيرتي. حياتي، ثم تنشر قصة حياتي في كتاب يُحقق مبيعات ضخمة.
(5)
كان ما يجري أشبه بحلم، لكنه كان الواقع، وإنما الحلم هو ما لازمني منذ صغري لأكون رسامة، وها هو يتحقق.
لا نستطيع أحيانا أن نحقق أحلامنا في موعدها المأمول، لكن واجبنا أن نستمر في سقياها من حين لآخر، فمن كان يظن أنني سأبلغ 101 عامًا حين أُتوفى في العام 1961، وقد تحول حلمي من مجرد أمنية صغيرة إلى واحدة من أكبر النجاحات في تاريخ عالم الفن.