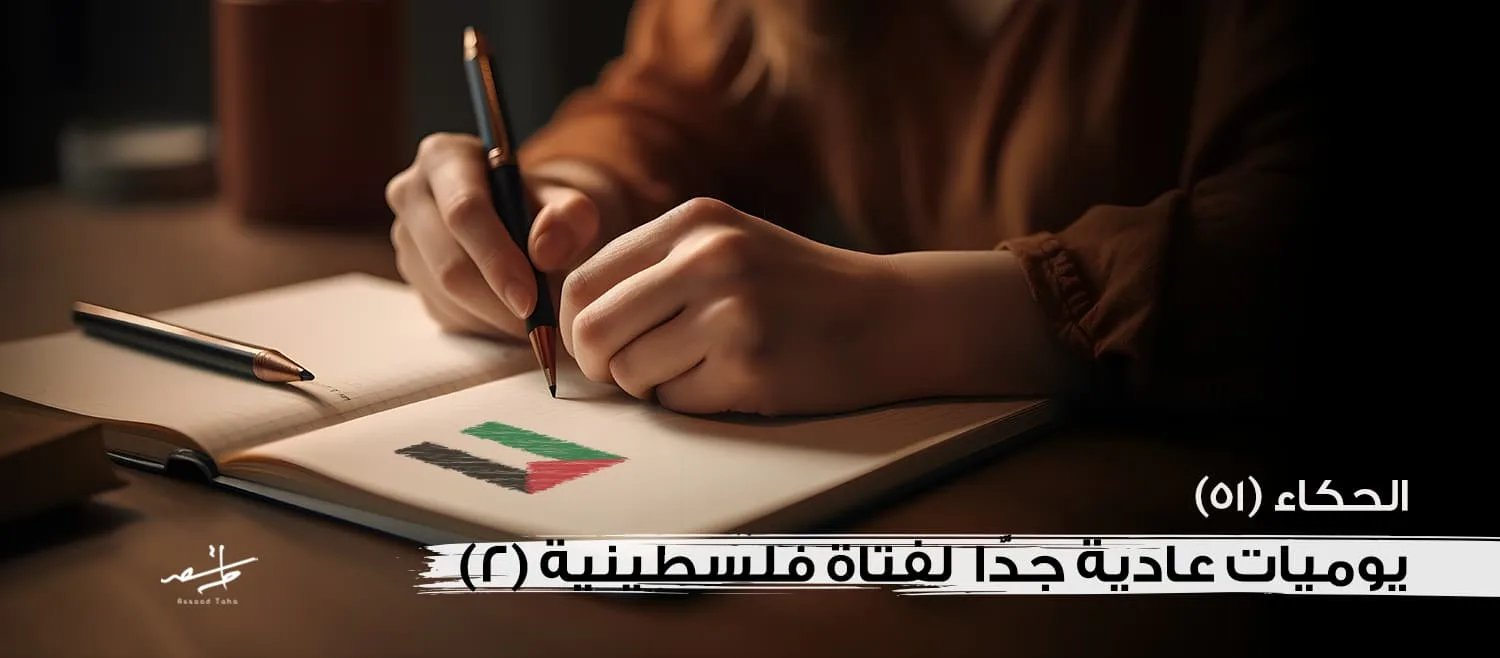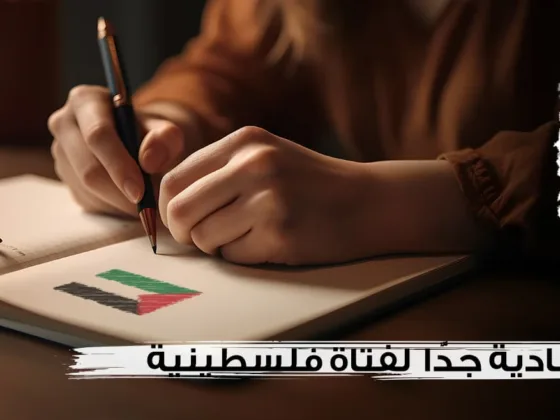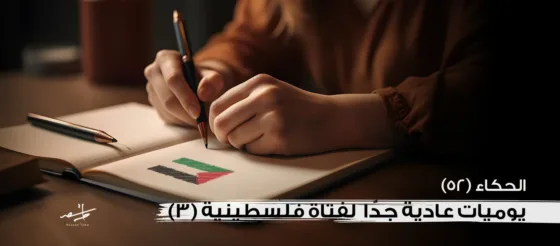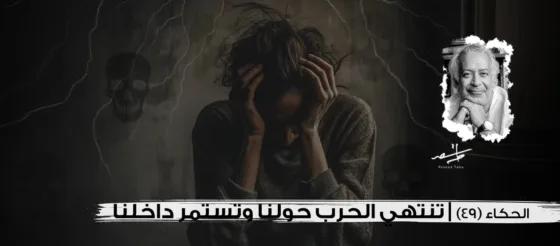(1)
هرعت أنا وإخوتي إلى النافذة، وكان لقاؤنا الأول معها.
أعرف الدبابة من الألعاب التي تشتريها أمي لإخوتي، شاهدتها مرة على التلفاز، لكن لم يخطر ببالي أنه يمكن أن أراها وجهًا لوجه، وأن يكون ذلك أمام بيتنا، تلحق بها مدرعات وناقلات جند.
(2)
كانت أيام الاجتياح الذي بدأ في التاسع والعشرين للشهر الثالث لعام 2002 من أصعب الأيام التي عشناها، لقد أصبحنا نكره الليل؛ خوفًا من خفافيشه، ونخاف النهار خشية من قناصيه، وما بين كل تلك الأوقات قلق وتوتر من المجهول الذي لا نعرفه.
لم يكد يمضي أسبوع على الحدث الجلل وأصوات المدفعية التي لا تنتهي، حتى عاد جنود الاحتلال هذه المرة بمدرعات كثيرة.
طرقٌ عنيف على الباب، وأصواتٌ بلكنة عربية مكسرة “افتخ (افتح) باب”، وقفتُ بجانب أمي، وأمسكتُ يدها فقالت لي بأن أبقى عند إخوتي الصغار، وذهبتْ لتفتح الباب، غير أني لحقت بها مسرعة، فتحتْ أمي الباب، وإذا ببنادق الجنود كلها في وجهها.
سيل من الأسئلة عمن في البيت، وكم عددهم، فأخبرتْهم أمي أن كلهم أطفال ونائمون، فتحول السؤال عن أين زوجك؟ فقالت أمي: إنه مسافر، فقالوا: أحضري كل مَن في البيت للصالة.
ردت أمي على الجنود، بصوتٍ حاد: “ولادي كلهم صغار ونايمين، ما تفوتوا جوَّا البيت حتى أصحيهم وأجيبهم على الصالة”، فقال أحدهم: “يلا بسرعة”.
دخلتْ أمي ونظرت إليَّ، وفهمتُ من نظرتها ما عليَّ فعله، فقد أوصتني من قبل في حال أن دخل الجنود البيت أن أخبئ النقود ومصاغها والأوراق المهمة التي يمكن أن يستولي عليها الجنود أو يُتلفوها، فلقد كان معهودًا عليهم سرقة البيوت عند الدخول إليها، وكان المخبأ ملابسي نفسها، بدأتُ بسرعة كبيرة أضع كل شيء في ملابسي، وادعيت البرد ولبست معطفًا كبيرًا.
نجلس جميعًا في الصالة، يفتش الجنود البيت، يطلبون هوية أمي وعمتي، يمكثون حوالي ساعة ونصف ثم يغادرون وهم لم يتركوا شيئًا على حاله، تتنهد أمي الصعداء، ترتب غرفة إخوتي وتنظفها من آثار الجنود وتعيد إخوتي للنوم فيها، ومن ثم تواصل مع عمتي ترتيب بقية البيت.
(3)
لا تزالُ مدرعاتُ الاحتلال في الشارع أمام البيت طوال الليل، فالجنود يفتشون كل بيوت الحي، وأصوات الطرق على الأبواب تمنع كل محاولة للنوم.
يغادرون ويشرق الصباح، لكن أصوات المدفعية التي تقصف مقرات الأجهزة الأمنية القريبة منا عادت لتدوي من جديد، الكهرباء مقطوعة وما من سبيل لمعرفة الأخبار سوى مذياع أبي الصغير، ننصت إلى إذاعة الشرق التي لم تبث برامجها المعتادة، وإنما تنقل بث قناة الجزيرة وقناة (أبو ظبي) في ذلك الوقت، نسمع صوت وليد العمري وشيرين أبو عاقلة عبر المذياع دون أن نرى الصورة، الأخبار مرعبة، خصوصًا من مخيم جنين.
يسأل إخوتي الصغار أمي: “ماما إحنا راح نموت”، تحاول أمي أن تخفف عنهم وتجيب بالنفي.
ومع استمرار الإغلاق وانتشار الجنود والدبابات في الشوارع، ينفد الخبز وينفد حليب إخوتي الصغار، وتفرغ ثلاجتنا تمامًا، خصوصًا أن من عادتنا التحوج اليومي لما نحتاجه لا التخزين.
تطلب أمي من عمتي أن تعجن قدرًا من الطحين لتخبزه على الفرن، تعد أمي مناقيش الزعتر؛ ليكون ذلك غداءنا مع أكواب الشاي.
نقْص حليب إخوتي الصغار يُقلق أمي، جار لنا يملك بقرة يتصل بأمي، يدعوها لتأتي إليه لتأخذ حصتها من الحليب.
أتولى المهمة، تقف أمي عند النافذة تراقبني، أذهب مسرعة إلى بيت الجيران، يبدو الأمر أشبه بفيلم أكشن، أعبر شارعين بسرعة البرق، أحصل على الحليب، وبنفس السرعة التي ذهبتُ بها، كان عليَّ أن أعود، أعبر الشارع الأول، يقطع الصمت صوت المدرعات المسرعة وهي تجوب الطريق الذي يجب أن أعود منه.
تبدأ السماء في المطر، أتسمَّر مكاني على حافة الشارع قرب شجرة غادرتْها أوراقها، أو لربما تجمدت فيه، تمر تسع مدرعات، لا أعرف كيف لم يروني، أو لربما هي دعوات أمي ظللتني فنجوت أنا والحليب.
أصل أخيرًا البيت، تضمني أمي، ويداها ترتجفان من خوفها عليَّ، لا أتحدث بعدها لساعة، تقول عمتي ضاحكة: إنه قد عقد لساني، قد يبدو الأمر ليس بهذه الدرجة من الرعب، لكنه كذلك بالنسبة لطفلة في الحادي عشر من عمرها، على كل حالٍ فإنه ورغم كل الخوف الذي عشته صرت أقوى استعدادًا لما هو آت.
الزياراتُ الليلة المتواصلة لا تنتهي، يعود الجنود ليلًا عند الساعة الـ 12:21 دقيقة تمامًا، هكذا كتبت في دفتر مذكراتي، يطرقون بقوة باب البيت، ويعلو صراخهم، نستيقظ جميعًا مفزوعين، ترتدي أمي حجابها وتفتح الباب، يقتحم جنود الاحتلال البيت، أفعل ما أفعله كل مرة، أخبئ كل ما طلبت أمي مني أن أخبئه، أحمل أخي الصغير عبد المجيد الذي بالكاد بلغ عامه الأول وأجلس.
يسأل قائدهم أمي: “ندى.. وين زوجك؟”، تقول له بأنه مسافر، يصرخ فيها: “ليش بتكذبي يا ندى، زوجك مش مسافر! ماجد حسن مش مسافر، وينه؟”، تقول له أمي: إنه هكذا أخبرها، يبقى الجنود في البيت لساعتين، يخرجون بعدها مع تهديد بأنهم سيعودون مرة أخرى، إلى أن يعرفوا مكان أبي.
(4)
يمر عام منذ أن انتقلنا إلى بيتنا الجديد، ولا تزال أمي تحاول أن تقتنص وقتًا بعد دوامها في المدرسة لتذهب إلى محل الستائر؛ لكي تختار واحدة جديدة، تدعو أبي لرفقتها، يعتذر لها وقد بات لا يخرج كثيرًا، وأصبح يؤجل كثيرًا من الأمور.
في تلك الليلة يصيبني الأرق، ولا أعرف النوم، أخشى أن أخرج من غرفتي؛ لأن ضوء الغرفة كان مطفأً، لكن ما إن صاح المؤذن: “الله أكبر” معلنًا أذان الفجر، حتى بت أرقب لحظة الفرج عندما يفتحُ أبي باب غرفته ليذهب إلى المسجد، وفي ذات الوقت تغمرني السعادة بأنه سيجدني مستيقظة ولا أتأخر على صلاة الفجر، لكن أبي لم يفتح الباب، أخاف أكثر فليس من عادته ألا يصحو لصلاة الفجر، وليس من عادته أيضًا ألا ينادي علينا لنصحو، يا الله ماذا يجري؟
أنتظر إقامة الصلاة في المسجد، وأستجمع قواي وأتمتم بما تدعو به أمي، أشعل ضوء الغرفة، أفتح الباب وأخرج، أسمع صوت أبي وهو يصلي، أرتاح قليلًا، أطرق باب غرفة أمي وأبي تخرج أمي، أسألها: “لماذا لم يذهب أبي إلى المسجد؟” تجيب بأنه يشعر بالتعب، وأنه سيرتاح قليلًا وسيكون بخير.
أذهب لإيقاظ إخوتي للصلاة، وبدء الاستعداد للمدرسة، يطلع الصباح، يخرج أبي لإيصالنا إلى المدرسة الإسلامية التي تبعد عن بيتنا عشر دقائق.
أغلب مَن في المدرسة يعرفون بعضهم البعض، فهم إما من نفس العائلة أو دائرة الأصدقاء، وما إن أصل ساحة المدرسة حتى تركض صديقاتي عليَّ.. “تسنيم.. تسنيم… عرفتي شو صار؟” ويا لهول ما حدث، جهاز المخابرات يعتقل عددًا من أصدقاء أبي، وهذا شيء لا يُنذر بخير.
أعود إلى البيت بعد يوم مدرسي، يعود أبي، نركض نحوه ونصيح “بابا بابا.. اعتقلو عمو ضياء وعمو أبو مصعب وعمو… وعمو… وعمو…” ورحنا نعد له الأسماء وأبي ينظر إلينا إلى أن يقول أخي الصغير أمجد: “بابا يعني بدهم يعتقلوك؟”
يضحك أبي ويمسح على رأسه.
يحل الليل، عند باب بيتنا ثمة أشخاص كثر وسيارات، أنظر من النافذة المطلة على مدخل البيت، يتكرر المشهد الذي يخلع في كل مرة الأمان من قلبي، أصيح: “ماما.. ماما.. بابا.. إجو المخابرات إجو المخابرات”، أهرع وإخوتي إلى أبينا، نمسك به، بل نتشبث به، نقول له: “بابا ما تروح معهم..”، لا تشفع لنا أعمارنا الصغيرة، ولا صوت بكائنا الذي أسمع الحي بأكمله، ولا رجاءات أمي لهم بأن لا يأخذوا أبي!
وهنا تبدأ رحلة جديدة مع السجون.