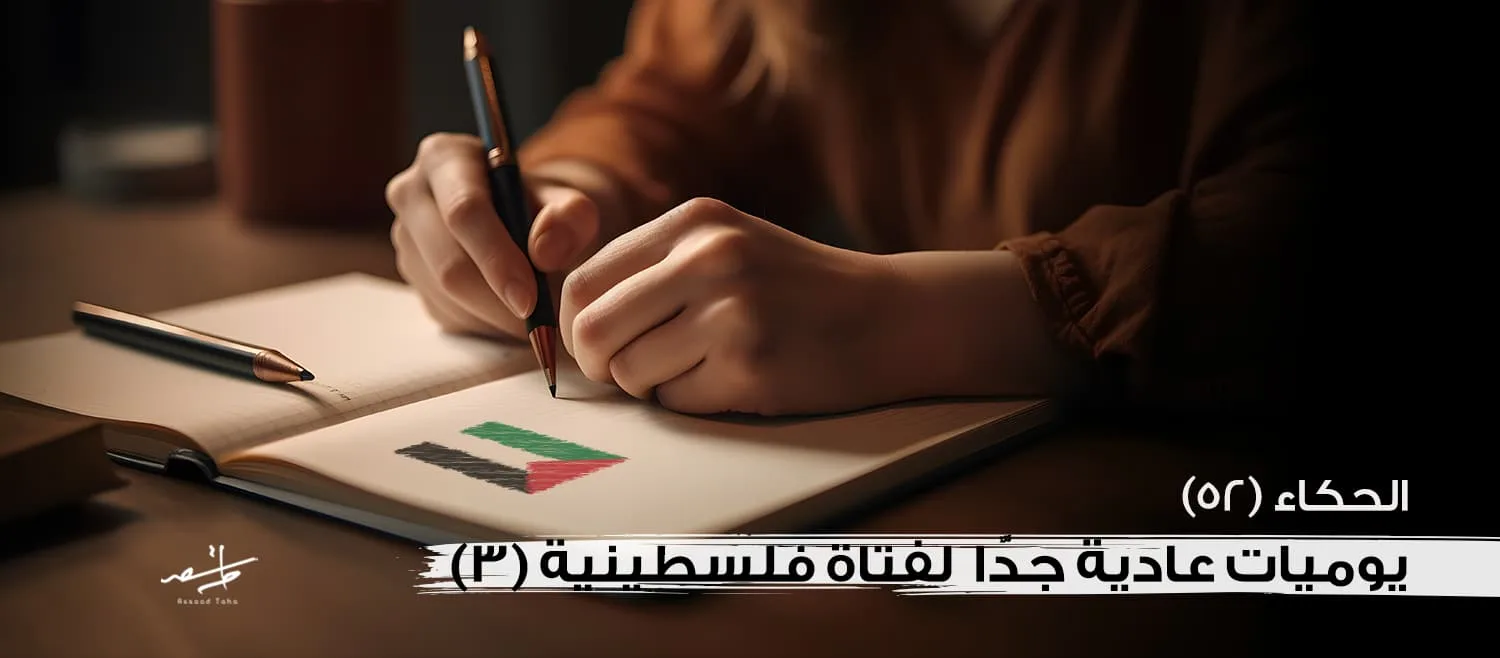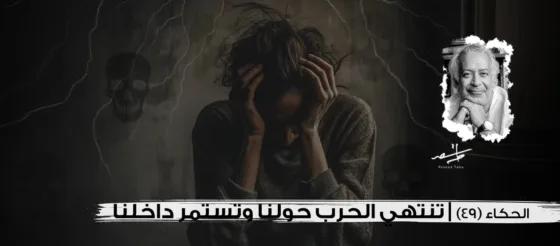(1)
يهدأ القصف المدفعي في إحدى الليالي، يسكن كل ما في الحي، أواصل كعادتي الانتقال من نافذة إلى نافذة، يُطلقون عليَّ: “برج المراقبة الليلي”؛ فأنا لا أغادر نوافذ البيت ليلاً؛ خوفًا من اقتحام أو مداهمة.
غير أني أرى هذه الليلة ما هو مختلف، شخصًا يمشي في الشارع المقابل لبيتنا بخطوات سريعة، لا يلتفت في أي اتجاه، أتابعه بنظراتي حتى يصل إلى عمارتنا، أركض لغرفة أمي لإيقاظها، وأخبرها بأن غريبًا دخل إلى العمارة، لم يكن هناك ليلتها كهرباء، تمسك أمي الشمعة بيد وتمسكني باليد الأخرى، نسير بخطوات ثقيلة نحو الصالة، نسمع طرقًا على الباب بصوت منخفض يكاد لا يُسمع، مِن خلف الباب نسأل: “مَن”؟ لا أصدق حين أسمع الإجابة، صرخت: “بابا”.
تفتح أمي الباب بسرعة، أعانقه بحرارة، يقبلني ورأس أمي، لقد مرت شهور طويلة ولم نعرف عنه خبرًا، تسأله أمي: لماذا أتى والوضع غير آمن؟ أرفع الشمعة قليلًا، يبدو وجهه شاحب اللون، وعليه حبات العرق رغم برودة الجو.
أبي مريضً جدًّا يومها، ولا يجد مَن يستطيع أن يحصل منه على دواء، فغامر وأتى إلى البيت رغم معرفته أن جنود الاحتلال قد يأتون في أي لحظة، يبقى 4 أيام بيننا لا يستطيع فيها أن ينهض من الفراش، وأنا لا أفارق نوافذ البيت في كل الأوقات، قمت بتقسيم إخوتي لفرق مراقبة نتبادل الأدوار، ولا يغفل أحد منا عن أي حركة في الحي، ثم يغادر أبي بيتنا، وعجبًا لأقدار الله، فبعدها بساعات، يعاود جنود الاحتلال اقتحام بيتنا.
(2)
تمر الأيام ثقيلة مجددًا، ويأخذ الوضع الأمني العام في الضفة الغربية منحى جديدًا؛ فتعود الحركة تدريجيًّا بعد تقليص ساعات منع التجول، وتقل أيضًا الاقتحامات، ثم تجمعنا أمي لتخبرنا أن إخوتي الأربعة سيعودون مع عمتي لبيتنا في القرية، أما أنا وعبيدة وعبد المجيد أصغرنا فسنبقى معها في رام الله.
بعدها تطلب مني أمي أن أضع ملابس عبد المجيد أصغر إخوتي في حقيبة المدرسة الخاصة بي، وأن أُحضر ما أحتاجه أنا أيضًا من ملابس، أسألها مندهشة: إلى أين سنذهب؟ تخبرني: عند بابا!
نغادر منزلنا وقد تركنا بعض المصابيح مضاءة لتوحي بأننا لا زلنا فيه، وهذا بالتأكيد في الحالات التي لا تنقطع فيها الكهرباء، نترك سيارتنا أمام البيت، ونستقل أخرى، نصل بعد أربع ساعات إلى البيت الذي يختبئ فيه أبي.
بعد يومين، كان عليَّ أن أعود مرة أخرى إلى البيت؛ لأطمئن عليه، خصوصًا وأن أمي في أشهر الحمل الأخيرة، يشرح أبي لطفلته التي تبلغ 11 عامًا طريق الوصول للمنزل، ويخبرني ماذا أفعل، يستودعني رب العالمين هو وأمي وأخرج أنا وأخي أمجد.
أصل بعد ساعتين وقد عبرت الطرقات الفرعية، أتأكد أن الاحتلال لم يقتحم بيتنا في غيابنا، أُحضر بعض الملابس من البيت، وأحمل جرة غاز متوسطة الحجم، إضافة إلى بعض الحاجيات التي أوصتني أمي أن أحضرها، أضعها في حقيبة وأحملها على ظهري، وأُلبس جرة الغاز كيسًا كبيرًا وألفها ببعض الملابس؛ حتى لا تكون واضحة المعالم، أنتظر بدء مغيب الشمس كما أوصاني أبي، وأخرج من البيت تسللًا.
(3)
أكاد أصل وجهتي المنشودة، إلا أن صوتًا قريبًا لدبابات ومدرعات يباغتني، أشعر أن قلبي يكاد يخرج من صدري من شدة الخفقان، وأظن أن موتي اقترب، أنا وأخي على طرف الشارع في مكان مكشوف تقريبًا ودبابات الجيش قريبة، لا أعرف ماذا أفعل، كان عليَّ أن أفكر هذه المرة وحدي، وأن أتصرف وحدي، يومها أظنُ أني كدتُ أكسر يد أخي أمجد وأنا أمسكهُ من شدةِ خوفي عليه.
أعود سريعًا إلى الخلف، ونختبئ خلف شجرة كبيرة، أرى بيتًا قديمًا له بوابة حديدية مفتوحة، نركض نحوه بسرعة، وأجلس أنا وأمجد بقرب البوابة على الأرض، أضع جرة الغاز خلفي وأحضن حقيبتي وأضع رأسي عليها، أشيح ببصري عن الدبابات التي تقترب، وأعد الثواني حتى تمر، إلا أن الثواني تصبح ساعات طويلة عندما تتوقف الدبابات ومدرعات الجنود على طول الشارع.
تغيب الشمس ويحل الليل، يعود صوت الدبابات مرة أخرى ليعلو من جديد، يبدو أنها كانت استراحة مفاجئة والآن سيكملون المسير، هكذا قلت لنفسي أطمئنها، وفعلًا كان هذا الأمر، وتمر الدبابات ومدرعات الجنود، نخرج من خلف الباب، ونركض بسرعة كبيرة حتى نصل البيت عند أمي وأبي.
أجدهما بحال لا يحسدان عليه، تضمني أمي طويلاً وهي تبكي، أقول لأبي بفخر: إنني أحضرت جرة الغاز وما طلبته أمي، وإنني قد استطعت أن أختبئ أنا وأمجد من الجنود، كنت أحاول جاهدة أن يشعر أبي وأمي بالفخر بي؛ لعل ذلك يبدد شيئًا من خوفهما عليَّ الذي كان واضحًا، ولوم نفسهما لإرسالنا في مهمة أشبه بالمستحيلة.
(4)
لم تمحُ سنوات ما بعد الاجتياح كل ما عشناه فيها، بقي عالقًا فينا بشكل أو بآخر، نجدهُ يخرجُ كلما أُعيدت بعض المشاهد والذكريات، حيث اعتقل أبي حينها ومكثَ في سجون الاحتلال ثلاث سنواتٍ ونصف، دون تهمة ودون محاكمة وبحكم “الاعتقال الإداري”. لم يكن شيئًا عاديًّا ولا طبيعيًّا، لكن أمي كانت قادرةً أن تكون لنا أمًّا وأبًا، لا ننسى كم كافحتْ وتحملتْ في سبيل ذلك. لكن ما حدث بعدها لم يكن خاطرًا لعقولنا أبدًا من قبل.
كان يوم الثامن من الشهر السابع لعام 2007، ليلةٌ صيفيةٌ جميلة بعد اجتماعٍ عائلي عشناه، كنا قد حُرمنا منهُ لسنوات، وكعادتي أنا “برجُ المراقبة الليلي”، لم أكن قد نمتُ بعد، عندما سمعتُ صوت الجيبات العسكرية أمام البيت، ركضتُ لإيقاظ أمي وأبي.. “جيش.. جيش”، وتخيلتُ أن الاعتقال عاد ليسرق أبي منا من جديد، لكن الصدمة هذه المرة كانت أن الاعتقال لأمي، وقفتُ وأنا لا أستطيعُ استيعاب ما يحدث، كيف تُعتقل أمي، عالمي ودُنيتي ورفيقتي وحبي الأكبر.
كان أبي يتجادلُ مع الضابط، وأمي تُعانقني وتوصيني بوصاياها المعتادة التي أحفظها عن ظهر قلب، أكمل أبي جداله مع الضابط والمجندة تضعُ القيود في يد أمي، لكن أمي وقفت وقالت لأبي: “ماجد ما تخاف، ندى جبل”.
(5)
اعتقلت أمي لخمسة أشهر، منها 35 يومًا في تحقيق المسكوبية، هُددت بي وبإخوتي، واقتحم الجيش بيتنا في ليلة عيد ميلادي وكانت أمي حينها في التحقيق، وأوهمها المحقق بأنني وأبي في الغرفة المجاورة لها، وأن إخوتي الثمانية في المنزل وحدهم، لكن أمي فعلًا كانت جبلًا شامخًا لم تهتز، وقالت له: الله معهم.
لكنه المحتل، لا يمكن أن تتخيل ما قد يُقدم على فعله، فقبل الإفراج عن أمي بقرابة الشهر، اعتقل أبي، وبقيتُ أنا وإخوتي الثمانية وعمتي لوحدنا، كان عليَّ أن أكون هذه المرة أمًّا وأبًا وأختًا كبيرة عمرها سبعة عشر عامًا، عليها أن تهتم بإخوتها وتتابعَ تفاصيل اعتقال والديها وتسأل المحامين كل يوم: هل من جديد؟
(6)
بعد هذه السنوات، أظن أن قراري كان صائبًا جدًّا، بل إنني غاية في السرور به، أن أدون كل ذكرياتي؛ فحياتي كطفلة وكشابة فلسطينية غنية جدًّا بالأحداث، أراهن أن لا أحد يعيشها في عالمنا العربي؛ لقد قضيت طفولتي ومراهقتي أتردد على السجون، وأخشى الاقتحامات، أشتاق إلى أبي المعتقل، ثم أقوم بدور الأم كاملاً بعد أن اعتقلوا أمي، وهددوا بتفجير بيتنا، لأكبر وتعاد المشاهد من جديد مع إخوتي شذى ومحمد وعبد المجيد الذين غيبتهم السجون في ذات الفترة، وكان عليَّ أن أعيش كل التفاصيلِ من جديد.
أنا هنا لا أسرد بطولتي، فقط أخبركم أن هذه هي الحياة العادية لفتاة فلسطينية، بل ما ذكرته هنا جزءًا يسيرًا.
اسمي تسنيم ماجد حسن.