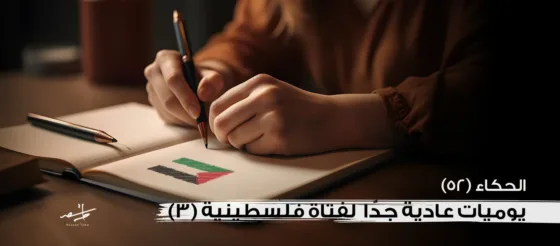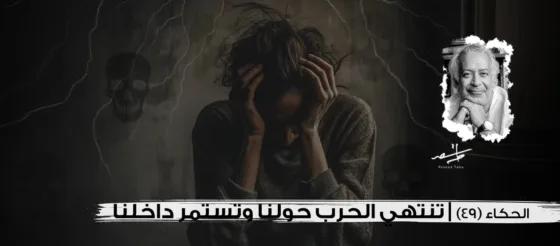عندما تسافر الفتيات إلى أفريقيا – (2)
(1)
فهمتُ الأمر الآتي: أرادت الدنيا أن توجِّه لي صفعة قوية، لعلي أنتبه إلى نعم الله التي لم أقدرها، وكنت أتململ وأشكو، أيقظني المرض العضال على حقائق كثيرة، يقظتي في حد ذاتها نعمة، فكم من مصفوع يظل في غيبوبته، شهيتي للسفر طريقة للاستكشاف انفتحت عن آخرها، رحلتي القاسية لأربعين يوما في أفريقيا مع مجموعة لا أعرفها، ثم عشرين يوما وحدي؛ لم تكن بغرض الاستمتاع بمشاهد أفريقيا الخلابة، لم أكن سائحة أبدا، كنت مسافرة، كانت رحلتي داخلية تماما، وإن بدت غير ذلك.
(2)
كانت الأيام تمر سريعا، وقضينا في السفر بالشاحنة أكثر مما قضينا في أي نشاط آخر، فمنطقة شرق أفريقيا شديدة الاتساع، تغطيها المساحات الخضراء والرطوبة المرتفعة.
نقطع الطريق من جنوب أفريقيا حيث التقت مجموعتنا إلى ناميبيا، مئة وثمانون كيلومترا تنقلنا من المساحات الخضراء المورقة إلى الشجيرات الجافة والصخور.
لن يكون بوسعي أن أحكي لكم ما جرى معي يوما بيوم مدة شهرين؛ بل ليس بمقدوري أن أصف روعة المشهد أمام مخيمنا الثاني على أرض ترتفع بضعة أمتار فوق نهر “أورانج” البالغ طوله تسعمائة كيلومتر، ويفصل بين جنوب أفريقيا وناميبيا.
بعده كان ينتظرنا أخدود “سيسريم” (Sesriem)، وهو مزيج من الرمل والحصى بأحجام مختلفة، أودعت في الأخدود بينما يتدفق النهر من خلالها، التكوينات الصخرية فاتنة، والخطوط المحفورة على الصخور تمتد عبر معظم أجزاء الأخدود.
من بين الشجيرات التي جفَّت استطعنا تمييز الحمر الوحشية الجبلية، إنها تقف في مواجهتنا بظهورها ذات الخطوط السوداء والبيضاء، وفي اللحظة التي نتوقف فيها تستدير لتُرينا جمالها المهدد بالانقراض، بطونها ناصعة البياض.
في الطريق نمتع أنظارنا بطائر الحبَّاك الذي يضفر أعشاشه بما يجمعه من العشب القاسي، في كل دقيقة تظهر العشرات من هذا الطائر تحمل العشب بين مناقيرها لتصنع الأعشاش، عدد الأعشاش في الشجرة لا يصدق، إنهم يستمرون في هذا سنوات حتى لا تعود الشجرة قادرة على تحمل المزيد منها فتسقط.
كان علينا أن نبذل جهدا شديدا للسير خلال كثبان رملية صغيرة بأحذيتنا الثقيلة، وكان عقلي يتساءل عن الظروف التي اضطرت قبائل “البوشمن” إلى العيش فيها في الماضي، وحتى الآن، ومن غرائب هذه القبيلة أنهم يتخلون عن أصغر أفرادهم أو أكبرهم سنا حين يشارف مخزونهم من الطعام أو الماء على النفاد، باعتبار أن الرضع والمسنين هم الأضعف والأصعب في الرعاية، كانوا يتركونهم ولا ينظرون إلى الوراء أبدا.
أما “ديدفلي” -وما زلنا في ناميبيا- فإنها تبدو كوعاء من الطين محاطة بالأب الكبير والأم الكبرى؛ أجل، هذان هما الاسمان الحقيقيان، إنهما أكبر الكثبان الرملية في العالم.
تبدو لي تكوينات الطبيعة مذهلة، منها تشكيلات رائعة على الرمال تكونت بأشكال مختلفة، وفيما بينها شقوق تكشف لك القليل من الألوان، فيما تثير الأشجار التي جفت ذات التسعمئة عام في نفسك الخوف.
نمنا ليلة في العراء خارج خيمنا، أنظر إلى السماء، إنها مليئة بالنجوم، ليس فيها مكان لنجمة أخرى، كانت كلها تلمع، وفي كل مرة أردت أن أغمض عيني كنت أحاول أن أبقيهما مفتوحتين حتى لا أضيع فرصة ربما لن تتكرر مرة أخرى، وبينما استغرق الجميع في النوم، بقيت مستيقظة لساعات؛ فلم أكن أريد أن أحلم بشيء سيكون -بكل تأكيد- أقل بهاء من منظر النجوم.
أما بلدة “سواكومبوند”، فقد أسَّسها الغزاة الألمان للسود العاملين، وتسكنها قبيلة هيريرو، واحدة من أكبر القبائل في ناميبيا، ترعى الماشية، وتتحدد فيها رتبة الفرد بعدد الماشية التي يمتلكها، ملابسهم التقليدية مستوحاة من الألمان؛ إنها تذكير دائم بتاريخهم، وهم يرتدون الملابس التقليدية من لحظة الزواج، وقبعاتهم واسعة على شكل قرون الماشية.
لا تتزوَّج فتيات القبيلة إلا بموافقة أعمامهن، والرجل يمكنه أن يتزوج 4 نساء، مثل المسلمين، لكن الحمد لله يجب أن يحصل الزوج على موافقة زوجته الأولى إذا أراد أن يتزوج أخرى، لتقرر إن كانت ستسمح له أم لا.
البلدة مليئة بمجموعات عرقية مختلفة، تجد كل واحدة منها طرقا متعددة لتبقى على قيد الحياة، ومنها: اكتشاف الأعشاب التي تعالج الأمراض، وطرق للطبخ دون غاز أو كهرباء. إنه شعور غريب حين ترى كيف تتحداك الحياة، فقط لتبقى، وامتلاك أساسيات الحياة يجعلني أدرك كم أنا محظوظة. إنها تجربة كاشفة حقا.
في السفر أستمتع بمشاهدة “سبيتزكوبي” (Spitzkoppe)، وهي مجموعة من قمم الغرانيت التي يبلغ ارتفاعها 1700 متر فوق سطح الأرض، ويقال إن عمرها 150 مليون سنة. إنها قمم ضخمة، وداكنة، وناعمة. والصخور الصغيرة من تحتها توفر لك طريقا لتتسلق إلى الأعلى.
أما حديقة “أتوشا” الوطنية، فإنها تضم المئات من الأنواع الحية، فأرى قطيعا من الظباء مجتمعا تحت شجرة، وبعدها أرى أنواعا مختلفة، إما تسير باتجاه حفرة مياه أو تحيط بها.
جاءت زرافة أنثى أولا، واقتربت جدا حتى أمكننا مقارنة ارتفاعها بارتفاع شاحنتنا، وقفت بارتفاعها الشاهق، واقترب جانبها منا، وعندما لاحظت وجودنا استدارت عابسة.
يحذرنا المرشد من التخييم بالقرب من فتحة للمياه يشرب منها: الأسود، ووحيدو القرن، والزرافات، والفيلة، وغيرها الكثير، وبسبب ذلك التهم أسد في العام الفائت أحدهم عندما غره المشهد، فنام بالقرب من فتحة الماء.
أما في “بتسوانا” فإن أي حركة على زورق الموكورو وهو يخوض بنا في النهر عند دلتا “أوكافانغو” (Okavango) ستجعلنا نسقط في الماء، فيما تحيط بنا الحشرات الطائرة، والثعابين المائية، والأسماك، والحيوانات، وهذه الزوارق التي نركبها مُصممة بطريقة تجعلنا بمحاذاة مستوى الماء حين نجلس فيها، والقصب يغطي رؤوسنا. كان الماء صافيا إلى حد ما، تغطيه الأوراق والنباتات التي تنمو من تحته، كان زنبق الماء المتلألئ الطافي على سطح الماء يغطي الدلتا البرونزية والسافانا، كان جمال الدلتا لا يُصدَّق.
في بتسوانا تحتل حديقة “تشوبي” الوطنية بقعة مهمة في موسم الجفاف، يمكن للزوار رؤية الحيوانات التي تتجه إليها، لكونها مكانا لتبريد أجسامهم وشرب الماء، وهي أيضا البقعة الأكثر تركزا للحياة البرية.
قابلنا عائلة من القردة تحيط بالأشجار وتراقبنا بحذر من كل منفذ يمكنهم رؤيتنا من خلاله. كان نهر “تشوبي” واسعا ومتعرجا، وكانت السماء شديدة الزرقة، فيعكس النهر ألوانها، وتزيده أشعة الشمس الناعمة بهاء.
تلك هي المرة الأولى التي نرى فيها فرس النهر عن قرب، ثلاثة أرباع جسمه في الماء، والربع الآخر -بما في ذلك الأذنان والعينان- فوق الماء يراقب الوضع من حوله، مع أن فرس النهر لا ينبغي له أن يقلق بشأن أي شيء، كونه واحدا من أخطر الحيوانات وأكثرها فتكا، دائما لديه طائر أو أكثر يتحصل على طعامه من الذباب الذي يطوقه.
أما زامبيا، فإنها معروفة بـ”شلالات فيكتوريا”، وهي من أكبر شلالات العالم، أمامها “مسبح الشيطان”، وهناك أجمل قوس قزح يمكن أن تراه في حياتك.
ثم اتجهنا إلى “مالاوي”، واحدة من أفقر دول العالم، لكنها من أجملها، وهي معروفةٌ بثمار المانجو الخضراء الفاتنة التي تتساقط من كل شجرةٍ تراها؛ وهي ألذ مانجو تناولتها في حياتي.
خيمنا على “شاطئ كاندي”، الذي يعد جزءا من بحيرة مالاوي، بدا كأنه بحر؛ فهو يمتد على 3 دول مختلفة، هي: تانزانيا، ومالاوي، وموزمبيق، وهناك كان علينا أن نسأل الموظفين إذا كانوا قد رأوا تماسيح في الأيام الماضية لنتأكد من أننا يمكننا السباحة بأمان.
زرنا مدرسة بها 10 مدرسين لأكثر من ألف طالب، ومشفى يتعامل مع مئات حالات الوفاة كل شهر بسبب الملاريا وحدها، لنقص شبكات الناموس، التي تبلغ قيمتها 10 دولارات وتنقذ أسرة كاملة، كان من المؤلم رؤية كم من قلوب قد تحطمت هنا.
وصلنا “دار السلام”، عاصمة تنزانيا، إنها تعج بالناس، يشترون ويبيعون، يصرخون ويصيحون، رجال ونساء يمارسون الرياضة بزيهم العسكري. كان كل شبر من الطريق يشهد شيئا ما. ثم كانت حركة المرور أسوأ أعدائنا، فقد قضينا 4 ساعات لم نتحرك فيها سوى 30 كيلومترًا، وكان علينا الامتناع عن السوائل لعدم وجود مراحيض؛ لذلك كان خيارنا الوحيد هو الآيس كريم.
كانت “جزيرة زنزيبار” في انتظارنا، ذهبنا إلى أجمل شاطئ رأيته في حياتي: “نانغوي” رماله ناعمة تبرز بين ظلال الأزرق الملكي والداكن، وكانت المياه شفافة تكشف لنا الحياة البحرية تحتها بوضوح.
كنت في قمة سعادتي ونحن نتجه إلى الشمال من تنزانيا، لمشاهدة فوهة “بركان غورونغورو”، الذي كان نشطا منذ ما يزيد عن مليوني عام، قبل أن ينفجر ويُشكل بانفجاره حفرة هائلة في الأرض يبلغ عمقها 610 أمتار، اختيرت واحدة من عجائب أفريقيا الـ7؛ ورؤيتها من أعلى نقطة أكدت ذلك.
في الطريق رأينا مجموعة من الفيلة والجاموس ترعى في أرضٍ خصبتها المعادن الطبيعية، الأمر الذي يفسر اسم “غورونغورو” الذي يعني “هدية الحياة”.
في طريقنا إلى فوهة بركانية أخرى هي “سيريجينتي” بدأنا نلمح الزرافات، والحُمُر الوحشية، وكثيرا من الحيوانات الأخرى، مررنا بالتلال والحواف الضيقة حتى وصلنا إلى المدخل لنلتقط صورة جماعية.
يقال: إنَّ صناع فيلم “الأسد الملك” أتوا إلى هنا، واستلهموا منها المنظر الطبيعي الذي شاهدناه في الفيلم.
في يومنا الأخير توجهنا إلى كينيا، حيث سيكون وداعنا. ربما كان الوداع هو أصعب ما في الرحلة؛ فحقيقة أنك لا تعرف متى سترى مرة أخرى أشخاصا صاروا كعائلتك وتشاركت الكثير من الذكريات معهم، إنه أمر ليس باليسير.
(3)
في السفر هزمت مخاوفي وفعلت ما لم أتخيل يوما أن أفعله، كيف أنصب خيمتي، كيف أخوض في نهر حتى منتصفه غير عابئة بمياهه غير الصافية.
كيف أتوغل في صحراء ناميبيا مشيا على الأقدام لـ3 ساعات في درجة حرارة تزيد عن 40، وظننتها تفوق صيف الخليج.
كيف أتجنب قرود البابون التي تتحين الفرصة لمهاجمتك، وكيف أجبر نفسي على البقاء في خيمتي حتى الصباح مهما كانت حاجتي حتى آمن شرها.
في السفر سوف أنصت إلى نصيحة مرشدتنا بألا أغادر خيمتي ليلا إلا عند الضرورة القصوى، وإذا اضطررت لذلك فعلي أن أحمل شعلة متوهجة وأجعلها في مواجهتي لا إلى الأرض حتى لا تصدمني فجأة قرون المها فتخترق جسدي.
وفي السفر سأتعلم كيف أستيقظ في الرابعة والنصف صباحا لأتسلق الكثبان الرملية، وسوف أضطر أن أخفي عن والدي أنني سأقفز من الطائرة على ارتفاع 10 آلاف قدم حتى لا يجبرني على العودة حالا.
سأفعلها فوق صحراء “ناميب” وأمام المحيط الأطلسي، سأرتدي في الطائرة بذلة القفز فوق حجابي، وسيرفعون صوت الموسيقا الصاخبة لإثارة حماسي، وسيقولون لي لن ندعك تقفزين قبل أن تبتسمي، سأجلس على حافة الطائرة وأنظر إلى الأسفل، سوف يصيبني الهلع ثم أصيح فجأة: “ليس هناك وقت للخوف”، لتبدأ دقائق من الحرية.
سوف يصيبني الهلع ثانية خوفا من ألا تفتح المظلة، لكنها تفتح وتسحبني بقوة إلى أعلى، وسأشعر أن الكون توقف عن الحركة، وأن الهدوء والسكون سيدا الموقف، ولا شيء سوى السماء، وتحتي الكثبان البرونزية، وبجانبها المحيط بلون “الكوبالت” المتداخل مع خيوط من الأزرق الغامق تمثل الأمواج.
كنت أشعر بالفخر لأن الأسباب التي كانت تدعوني إلى عدم المغامرة قد هزمتها تماما، حتى وإن كنت أضحك أو أبكي، أو أتلو الشهادتين حين يتوقف نفسي أحيانا.
إذن كنت قادرة على فعل ذلك كله، والتغلب على كل تلك المخاطر في عالم لم أتخيل نفسي جزءا منه بسبب مخاوفي، أنا الآن أملك قلبا من حديد، وعقلا يزدهر بالأفكار، لم أكن أدري أن لدي كل هذا.
أترى حين تسافر يظهر جانب جديد من شخصيتك، ربما لا تعرفه عائلتك نفسها، جانب شديد الهشاشة والقوة، جانب تظهر فيه ذكاءك وغباءك معا. يمكنك أن ترى بوضوح كم تغيرت شخصيتك بعد السفر.
كان والداي ينصحانني دوما بأهمية أن أكون قادرة على أن أقضي بعضا من وقتي وحيدة “يجب أن تتمتعي بصحبة نفسك لكي تتمكني من التمتع بصحبة الآخرين”. وقد فعلت ذلك مدة عشرين يوما بعد أن أنهيت رحلتي مع المجموعة.
في السفر لم أر فقط أماكن مختلفة؛ بل التقيت أناسا من خلفيات مختلفة، ربما يرون العالم بطريقة مختلفة، لذا فالسفر يجعلك ترى أكثر.
مغامرتي تأتي بعد تجربتي المؤلمة مع هذا المرض العضال، وكنت قد سلمت أمري لله، ثم أديت واجبي في المقاومة، وقد انتصرت في الحالتين؛ في المرض، وفي السفر.
بالمناسبة اسمي مريم، مريم بنت هذا الحكَّاء.