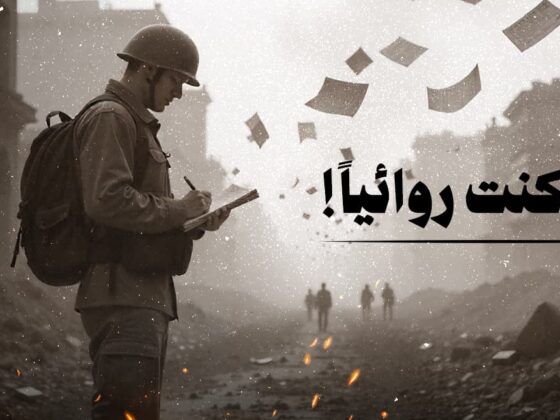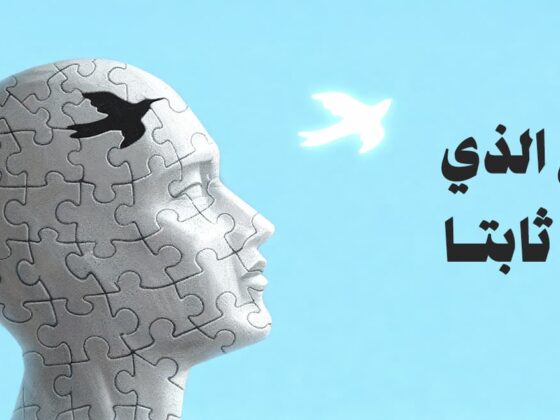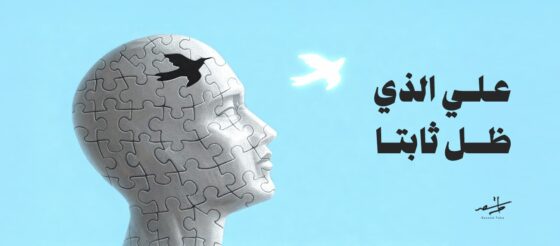(1)
الكتابة تغار، تأبى أن يشغلك عنها -وأنت في حضرتها- أيُّ شاغل، ويُدرك الكتَّاب هذه الحقيقة، ولهذا يلجؤون إلى العزلة، يحبسون أنفسهم في مكان ما بعيدًا عن العائلة والأصدقاء، ويمضون في مشروعهم الكتابي، حتى إنه باتت هناك منتجعات للكتابة في مناطق طبيعية بعيدة عن العمران، بها أكواخ منعزلة عن كل وسائل الاتصال والتواصل، يقضي فيها الكاتب أيامه يكتب ويكتب دون مشتتات.
إنها “عزلة اختيارية”.
وقد رأى الظالمون أن يمنحوا بعض الكتَّاب فرصة أفضل للعطاء والإبداع.
فوضعوهم في “عزلة إجبارية”!
(2)
كُتب ما فيه الكفاية عن أدب السجون، وكيف خرجت منه أعمال إبداعية لافتة من: روايات، ومذكرات، وأشعار، وأشكال مختلفة من الكتابات.
فقرأنا “رسائل من السجن” لأنطونيو غرامشي، الفيلسوف الإيطالي الماركسي الذي كتب أعماله الفكرية المؤثرة أثناء سجنه في عهد موسوليني.
و”أرخبيل الغولاغ” لألكسندر سولجينتسين، ذلك العمل الضخم الذي وثَّق فيه الكاتب الروسي تجربة معسكرات الاعتقال السوفيتية، والذي كتب أجزاءً منه سرًّا أثناء سجنه.
أما “جاك هنري أبوت” فقد كتب “حجرة واحدة تكفي” عن تجربته في السجن الأمريكي.
ولا ننسى “موت إيفان إيليتش” لدوستويفسكي، وأعمالاً أخرى استوحاها من تجربته في المنفى السيبيري.
أما العالم العربي فقد كان كريمًا في هذا الشأن -بلا شك؛ فقرأنا لعبد الرحمن منيف روايته الشهيرة “شرق المتوسط”، والتي جسَّدت التعذيب والانكسار والأمل داخل المعتقلات.
ومن المغرب أبهرتنا رواية “تلك العتمة الباهرة”، التي استندت إلى شهادة عزيز بنين عن معتقل تازمامارت، وحصدت جوائز عديدة، ولها ترجمات واسعة.
وغيرهم العديد من الكتابات والكتَّاب، حتى أصبح أدب السجون ليس مجرد هامش في المكتبة العربية، بل مرآة لحقبة كاملة من الصراع بين الحرية والقمع، وسجلًا جمعيًّا يشارك فيه الأفراد بأقلامهم؛ ليكتبوا تاريخًا لم يُدوَّن رسميًّا.
(3)
لكن باسم خندقجي استوقفني من بين هذه الأعمال بروايته “خسوف بدر الدين”، وهو الأسير الفلسطيني المحتجز في سجون الكيان منذ عام 2004م، والمحكوم عليه بثلاثة أحكام مؤبدة، وقد أنهى أثناء سجنه دراسته الجامعية في الصحافة، ثم تابع دراسة العلوم السياسية في جامعة القدس.
باسم اختار أن يخرج عن معتاد أدب السجون، فلم يصف حياة الزنازين ومتاعبها، وإنما أطلق خياله إلى ما هو خارج السجن، وحلَّق بعيدًا جدًّا، ليعود بنا إلى أواخر القرن الرابع عشر الميلادي؛ ليتناول سيرة الشيخ الصوفي بدر الدين محمود، ابن قاضي قرية سيماونة إحدى قرى مدينة أدرنة في تركيا.
صحيح أن روح التمرد والثورة تطل بين صفحة وأخرى، كأنه قد حرَّر روحه بالفعل، كأن ما أعجبه في شخص بدر الدين أنه لم يستسلم للطغاة، كما لو أنه لا يكترث أن يكون القتل نهايته كنهاية بطله، طالما أنه مؤمن بقضيته.
لقد فكَّرت كثيرًا، كيف فعل فعلته تلك وهو في حاجة إلى مراجع تاريخية عديدة، كيف صبر مرتين، مرة على حماقات السجَّانين، ومرة على كتابة رواية من أكثر من ثلاثمائة صفحة؟!
بل لدي سؤال أهم، فقد يكون مفهومًا أن يخرج الكتَّاب من السجون فيكتبوا ذكرياتهم وأيامهم في شكل روايات أو مذكرات، لكن أولئك الذين يقضون عقودًا من الزمان في السجن، كيف يفعلونها؟!
كيف يكتبون وهم قيد الزنازين، تحت رحمة السجَّان وحماقاته، وفي ظروف غير آدمية؟!
بل كيف يُبدعون في أعمالهم تلك؟
من أين تأتيهم هذه الإرادة الفولاذية؟
وكيف تتفجَّر فيهم هذه الطاقات؟
(4)
في زنزانة باردة حد التجمُّد شتاء، لا تُحتمل صيفًا، انفرادية، أو مع حشد من المحكومين، لا أوراق ولا أقلام، ولا طاولة تتكئ عليها إضاءة جانبية، ولا فنجان القهوة، ولا موسيقى تملأ الغرفة، يكتب الكاتب المعتقل كتابه.
تخيَّل هذا السجين، جائع، مريض، مهان، يهاجم السجَّانون زنزانته من حين لآخر، يفتِّشون ما لديه؛ بحثًا عن ممنوعات، يتمنُّون لو يفتِّشون رأسه -أيضًا- بحثًا عن “فكرة” لا تروق لهم.
تخيَّل كيف يغامر ويكتب بأقلام مهربة على قطع من القماش أو الورق المقوَّى، وعلى أوراق المحارم الورقية، أو أوراق لف السجائر، يكتب بخط صغير ما يكتب، ويتحمَّل العقاب إذا اكتشف السجَّان الأمر!
كيف يطيق ذلك؟!
بل كيف يطيق أن يعود ويبدأ الكتابة من الصفر مرة أخرى إذا ما صادر السجَّان ما كتب؟
وقد لجأ بعضهم إلى الذاكرة، فيحفظ في رأسه ما يكتب؛ ليعيد تدوينه مرة أخرى في حال المصادرة، ونجح آخرون في تهريب ما كتبوا خارج السجن.
وهكذا فعل نغوغي واثيونغو حين كتب رواية “شيطان على الصليب” على ورق المرحاض (التواليت) في معتقل كاميتي في كينيا.
وكذلك أنطونيو غرامشي كتب “دفاتر السجن” على مدى عشر سنوات، وهي عبارة عن 33 دفترًا.
(5)
من أين تأتي هذه القوة الجبَّارة التي تنفجر في الأديب المعتقل، حتى يتحمَّل ما يتحمَّل ويكتب ما يكتب؟
هل تهبط عليه من السماء؟
هل يحتفظ بها في داخله؟
هل تخبئه نفسه عنه فلا يكتشفها إلا إذا حلَّت به مصيبة؟
لماذا لا نكتشف قدراتنا الداخلية ونعترف بها ونحن في أمان وراحة؟
لماذا لا نتعرَّف على قوة الداخل إلا عندما نُبتلى؟
لماذا نتعذَّر بأتفه الأسباب حتى لا ننجز مهمتنا أو ما نحلم به، بينما لدينا -في الحقيقة- كل القوة والقدرة لنحقِّق ما نريد تحقيقه؟
كما لو أن قدراتنا الداخلية تشبه الأنهار الجوفية، تظل ساكنة حتى تهتز الأرض فتتفجَّر عيونها.
فكَّرت أن الإنسان ليكتشف نفسه، يمكنه -مثلاً- أن يتجرأ على تجربة ما لم يجرِّبه من قبل، أن يقف في مواجهة خوفه بدل أن يفرَّ منه، أن يصرَّ على المحاولة حيث ينسحب الآخرون، وأن يصغي جيدًا لما يتغيَّر في داخله بعد كل تجربة.
هكذا، شيئًا فشيئًا، يتكشَّف له معدن صبره، وقوة عزيمته، ونقاء إيمانه بقدرته على المضيِّ.
إننا حين نُغامر في المجهول، وحين نتجرأ على اقتحام الصعاب، لا نكتشف العالم فقط، بل نكتشف أنفسنا، ونكتشف أن داخلنا أوسع بكثير مما ظنناه.