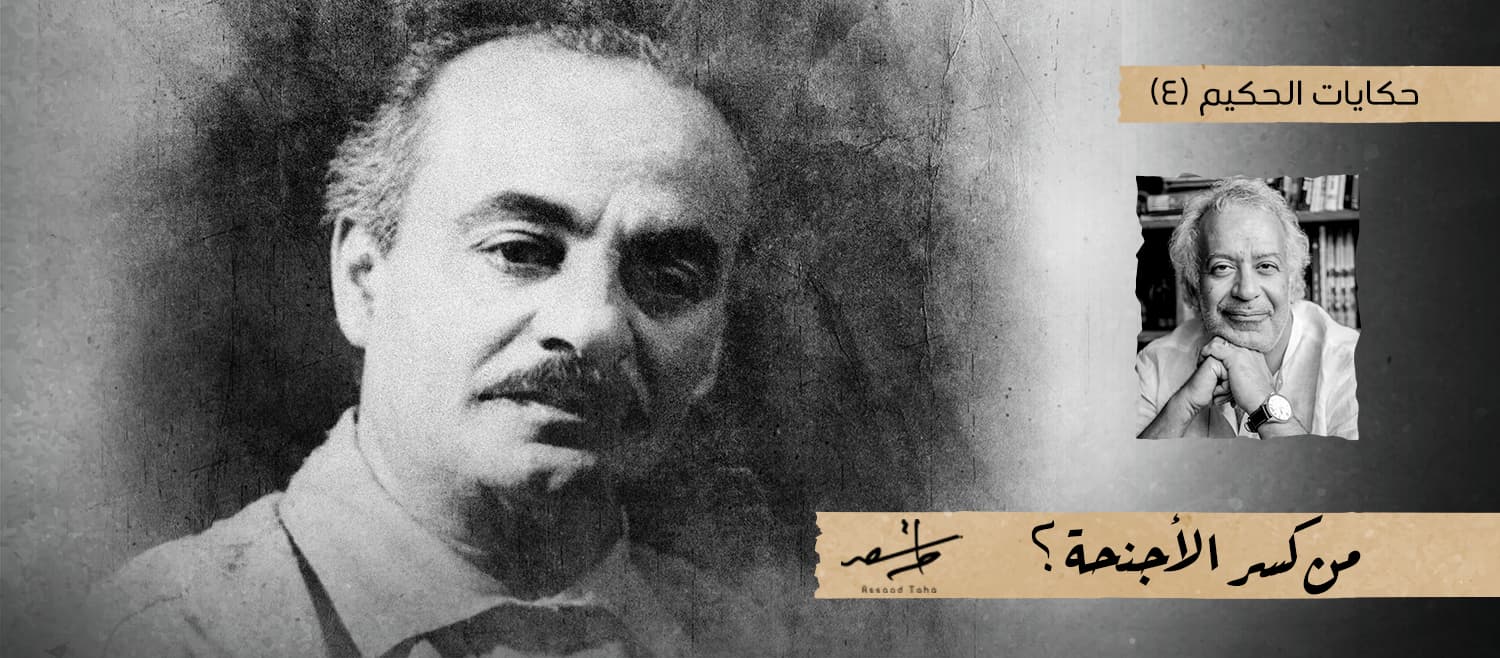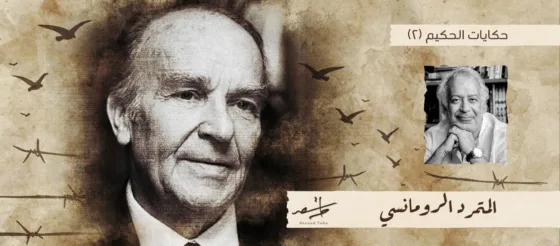(1)
يُحكم على الأب بالسجن، تبيع الأسرة ما تملك من متاع وأوانٍ متهالك؛ حتى توفِّر ما يمكنها من نفقات السفر؛ لتحل في واحدةٍ من أقدم وأضيق الأحياء في البلد الجديد، والمسمى بـ: حيِّ الصينيين.
تمر الأيام، والأم والأخت تمران على البيوت، تعملان وتخيطان الثياب، بينما يفتتح أخو الحكيم متجرًا صغيرًا، أما الحكيم نفسه -ذلك الفتى الصغير- فإنه يُسجل في صفوف المهاجرين؛ ليتعلَّم الإنجليزية، وهناك يُظهر اهتمامًا ملحوظًا بالرسم، ويتردد على مؤسسة خيرية دروسًا في هذا الفن، تلفت موهبته الفذَّة أنظار روَّادها، والسيدة المرموقة جيسي ذات النفوذ ليست استثناء، تعرِّفه بدورها على مدير لدارٍ للنشر، والذي قدَّمه هو الآخر إلى أصدقائه.
يقع الفتى الغرُّ فريسةً لزوجة أحد التجار الكبار، تبلغ من العمر ضعف عمره المراهق الجموح، يثير حفيظة أسرته الشرقية هذا الانفتاح والتردد المتكرر على تلك الأوساط المرموقة، خصوصًا مع تراجع اهتمام الفتى بالتصوير وتلقِّي العلم الذي لأجله يطرقون الأبواب ويخيطون الثياب ويتكفَّفون ما يسدُّ جوعهم.
ولربما خشيت “كاملة” الأم المحافظة أن تنجرف قدما صغيرها إلى الثقافة المغايرةـ ويتجاهل تراثه العربيَّ ويهمل لغته، فتقرِّر العودة إلى بلادها؛ ليداوم الفتى في مدرسة مسيحية؛ ليدرس هناك العربية، ويتعرف على كوكبة من المبدعين والأدباء والفنانين.
(2)
في أحد الصباحات الخريفيَّة من العام 1898، يسير صاحبنا من قريته قاصدًا مدرسته في بيروت، تقع عيناه على فتاة لا يعرف أنه سيخلِّد حكايتهما لاحقًا في واحدة من أشهر كتبه، والتي ستحصد له شهرةً منقطعة النظير.
إنها “حلا”؛ الحسناء اللبنانية ابنة الشيخ طنُّوس ذات السبعة عشر عامًا سليلة الأسرة الثريَّة، يخفق قلب الفتى البكر لها، يتطوَّر ما بينهما، وتستضيفه تكرارًا في بيت عائلتها الفخم.
لا تسير الأمور على خير أو بالرومانسية التي يتمنَّاها الحبيبان؛ إذ يكتشف أخوها مقابلاتهما في المنزل، فيمنعها من رؤيته، ويبلِّغ الفتى رفض العائلة الاقطاعية له، واستحالة علاقته بابنتهم.
هي تنسلُّ من عائلة متيسرةٍ ذات نسبٍ وحشم، بينما والد الفتى كان راعيًا للماشية، فقد عمله؛ لانشغاله بالقمار ومعاقرته الخمر وغرقه بالديون، وأُلقي -لاحقًا- بالسجن.
وبينما تربَّت هي في أسرة موسرة يخدمها الخدم، نشأ هو في فاقةٍ وحول نوبات وعربدة أبيه السكير، ورغم الرفض، لم يتوقف العاشقان الصغيران عن اللقاء في غابة أحد الأديرة.
لم يكن الفارق بينهما بسيطًا؛ ففي هذه الحقبة بالذات -التي يلفظ القرن التاسع عشر فيها أنفاسه- تشهد البلاد ظلامًا وحرمانًا عظيمين؛ فقد كانت البيئة الاجتماعية حينها تقرُّ تمايزًا طبقيًّا، وتعتمد إقطاعيةً ضارية زادت الفقير فقرًا والثري ثراء، هذا بالطبع وما تبعه من تعصب طائفي، فيما هما لا يعنيان سوى بحبهما الوليد، ولا يحسبان لشيء حسبة.
(3)
مرَّرت هذه البيئة السامة المظالم واحدة تليها الأخرى، ولم تكن لترأف بقلب صاحبنا، الذي يواجه الآن نوعًا مختلفًا جديدًا من الظلم الذي يعرفه ويعتاده ووُلِد فيه. ظلمٌ سلبه حبَّه الصغير، وشحن ثورته على المظالم الانسانيَّة والتمايز الطبقي؛ لتشكل مسار حياته منذ تلك اللحظة وحتى يموت.
أسابيعُ قليلة مرَّت منذ أن رفضته الأسرة الموسرة لفقره وردَّته عن الأبواب. يلتقي الفتى محبوبته ويبثُّ إليها ما يَلقى، وتنتهي أفكاره اليائسة بأن يهربا معًا، كأنما يتعلَّق بآخر أمل، لعل هناك أرضًا ما قد تسعهما دون اعتبارات المادة.
“إذا قطفت ثمرة نيِّئة من شجرة، فسوف تؤذي كلًّا من الثمرة والشجرة” بتلك الكلمات تردُّه حلا، وينكسر قلب صاحبنا، وتدفن الحكاية في أولها.
(4)
كانت تناديه أمُّه: “ملاكي”.
وسأَلَتْه يومًا: أين جوانحك؟
قال: جوانحي منكسرة!
(5)
العام 1912، هو العام العاشر منذ انكسار فؤاد صاحبنا، لكنه العام الذي يُطلق فيه للنور روايته الكبرى: “الأجنحة المتكسرة” لتكون من أشهر كتبه بالعربية وأذيعها صيتًا. يستوحي حكايتها من قصته مع حبيبته القديمة حلا، لكن اليوم يمنحها اسم: “سلمى كرامة”، ويكون هو بطلها، كأنما يعيش ذات السرد مرتين.
(6)
“في تلك السنة ولدتُ ثانية، والمرء إن لم تحبل به الكآبة ويتمخض به اليأس، وتضعه المحبة في مهد الأحلام، تظل حياته كصفحة خالية بيضاء في كتاب الكيان”.
“في تلك السنة شاهدت ملائكة السماء تنظر إليَّ من وراء أجفان امرأة جميلة، وفيها رأيت أبالسة الجحيم يضجون ويتراكضون في صدر رجل مجرم، ومن لا يشاهد الملائكة والشياطين في محاسن الحياة ومكروهاتها يظل قلبه بعيدًا عن المعرفة، ونفسه فارغة من العواطف”.
“إن المحبة الحقيقية هي ابنة التفاهم الروحي، وإن لم يتم هذا التفاهم بلحظة واحدة، لا يتم بعام ولا بجيل كامل”.
“المحبة هي الحرية الوحيدة في هذا العالم؛ لأنها ترفع النفس إلى مقامٍ سامٍ لا تبلغه شرائع البشر وتقاليدهم، ولا تسود عليه نواميس الطبيعة وأحكامها”.
“أيُّ فتى لا يذكر الصبيَّة الأولى التي أبدلت غفلة شبيبته بيقظة هائلة بلطفها، جارحة بعذوبتها، فتَّاكة بحلاوتها”.
ليكن وداعنا هائلاً عظيمًا مثل حُبِنا.
(7)
ظلَّت “حلا” تحتفظ بتذكارات فتاها إلى آخر أيام حياتها، كأعز أثر من أعز حبيب، وآثرت أن تظل عانسًا، إلى أن تتوفى عمياء في منتصف عام 1955، فيما لا يزال حبها لجبران مشتعلاً في قلبها.
أما فتاها الحكيم، جبران خليل جبران، الكاتب والشاعر والرسام، فقد عده العالم رائدًا من رواد النهضة العربيَّة، أثرى الأدب بمؤلفاته وقِيَمه التي أثَّرت بملايين الأشخاص حول العالم.