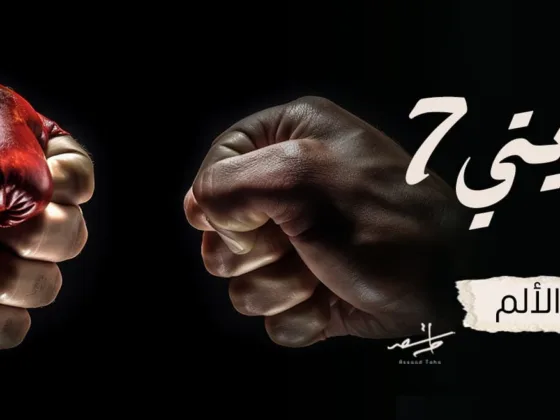(1)
في خطوة غير مسبوقة قرَّرت الحكومة الأمريكية أن تزيِّن بعض أوراقها النقدية بصورتي، نعم أن المرأة السوداء التي ستحل صورتي محل صورة الرجل الشهير ألكسندر هاملتون، أحد الآباء المؤسسين.
والسر في حكايتي.
(2)
اسمي: “أرمينتا روس”، ولدت عام 1822 لأبوين يرزحان تحت نير العبودية، ثم عُرفت بعد ذلك باسم: “هاريت توبمان”، أتوسط تسعة من الأشقاء والشقيقات، السيد الذي يملكني وعائلتي يعتقد أن العبيد ليسوا بشرًا أبدًا، وإنما حيوانات ناطقة.
يقرِّر يومًا أن يبيع شقيقاتي الثلاث، ولا يفلح صراخ أمي في ثنيه عن ذلك، ومشهد فراقهن المرعب لا يفارقني، فراق لن يكون بعده لقاء أبدًا، وأقرر أنني لن أستسلم أبدًا إذا بت في نفس الموقف.
في العام التالي يأتي تاجر عبيد آخر إلى مالكنا يطلب شراء عبد جديد، والدور هذه المرة على شقيقي الأصغر، تعلم الأم بالأمر فتقرر إخفاءه، يجن جنون المالك، لكن أمي تواجهه في ثبات وتحدٍ، تصرخ في وجهه: “من يقترب من هذا البيت سأشج رأسه”.
أُصاب بالهلع، أَتصبب عرقًا وأَرتعش.
يتراجع السيد بعد أن أدرك أن أمي جادة في تهديدها.
وأَخرج بدرس عظيم “المقاومة ممكنة”.
(3)
تمر الأيام، تقع حادثة فارقة في حياتي؛ فقد أرسلني سيدي لشراء بقوليات، فلما دخلت المتجر وجدت عبدًا آخر هناك، طفل في مثل عمري يحاول الهرب من المشرف عليه، يستنجد بي، فيما سيده يطالبني بالمساعدة في كبح جماحه، بالطبع رفضت ذلك بشدة، وقفت بين الرجل والطفل مما يساعد الأخير على الهروب.
المشرف اليائس يمسك بثقل رطلين من الميزان، ويلقي به على العبد الذي يحاول الهروب، تخطئه الإصابة، تضرب رأسي بضربة تكاد تقتلني، يسيل الدم بغزارة على جبهتي، وأفقد الوعي.
يحملونني إلى منزل سيدي وأنا بين الموت والحياة، ورغم ذلك يحرمونني من أي رعاية طبية، فأصاب بصداع مؤلم للغاية ونوبات من فقدان الوعي وهلاوس بصرية، وحين أسترد وعيي أصبح شخصًا آخر، شخصًا يؤمن أنه خُلق لمهمة أكبر من مجرد العمل لهذا السيد أو غيره.
ولأنني أصبحت مريضة فإن سيدي يحاول بيعي، وإذا بالمفاجأة أنه يموت، فينتابني خوف شديد مما سيحدث لي، يسيطر عليَّ سؤال واحد: كيف يمكن ألا أترك مصيري في يد سادة جدد؟
(4)
وجدت الإجابة!
أنا أعيش في ولاية ماريلاند، وتجاورنا ولاية بنسلفانيا التي ألغت العبودية وحرَّمتها.
فلماذا لا أهرب إليها؟
غير أن ذلك يحتِّم عليَّ أن أسير مائة ميل على أقدامي في تلك الليالي الشتوية مسترشدةً بنجمة الشمال، والأمر مرهون بنجاحي في الهروب من صائدي العبيد الذين يترصدونهم وكلابهم المتوحشة في الطرق، مدركة تمامًا أنه إذا أُلقي القبض عليَّ فإن ذلك يعني الموت.
المشكلة الأخرى أن مائة ميل سيرًا على الأقدام أمر قد يكون محتملاً، لكنها مسافة تمر بغابات شائكة ومستنقعات وممرات جليدية تفعل فعلها في الأقدام.
فإذا نجحت في عبورها فإنَّ عليَّ أن أُكمل طريقي بملابس مبللة في طقس شديد البرودة، وأن أختبئ إذا رحل الليل في الصباح في منزل من منازل المتعاطفين متنكرة في صورة وهيئة أخرى.
صدقوا أو لا تصدقوا لقد فعلت ذلك كله، نجحت -أنا الفتاة المسكينة- في الهروب، فقد صدق حدسي… إن “المقاومة ممكنة”.
أشعر -لأول مرة في حياتي- بطعم الحرية، لكن الوحدة تعصف بهذا الشعور اللذيذ؛ فليس هناك من يرحِّب بي، لقد بت غريبة في أرض غريبة، بيتي ما يزال في أرض العبودية، الكوخ الفقير مع العجائز وأخواتهن وإخوانهن، لكن أنا حرة، ويجب أن يكونوا هم -أيضًا- أحرارًا.
(5)
لقد قررت العودة إلى حيث كنت أعيش مع أهلي، ليس لأن أعاود الحياة بينهم، ولكن لأقود مجموعة منهم عبر نفس الطريق عائدة إلى ولاية الحرية، معتمدة على خبرتي التي اكتسبتها في الطريق.
وبالفعل أنجح في تحرير سبعين واحدًا، بل أكوِّن شبكة لتحرير العبيد، مدركة مخاطر الأمر، ومخاطر الطريق، لكنني حددت مسارات الهروب بدقة، حتى أَطلق الناس لاحقًا على هذا المسار اسم: “سكك حديد ما تحت الأرض”.
رغم أنه لم تكن هناك سكك حديد، ولم تكن تحت الأرض، لكن هكذا أُطلق على هذا المسار.
الجميل في الأمر أن مشروعي ألهم الآخرين، الذين راحوا يفعلون ما أفعله، لكنني ظللت متميزة، وكنت الوحيدة بينهم التي لم تفقد -في كل رحلاتها- واحدًا، حتى أطلقوا عليَّ اسم: “موسى”، تشبيهًا بالنبي موسى الذي قاد أتباعه للهروب من فرعون.
في الرحلة الأخيرة، وبعد انتهائي، أنظر إلى يداي وأسأل نفسي: أأنا نفس الشخص؟
إني أشعر حقًّا بالمجد، أنظر حولي فإذا بالشمس تأتي كالذهب عبر الأشجار وفوق الحقول.
يا إلهي كأنني في الجنة.
(6)
لا أكتفي بذلك؛ فبعد قيام الحرب الأهلية، أتطوع في قوات الشمال -لتحارب مالكي العبيد في الجنوب- كـ: طاهية وممرضة، أستخدم مهاراتي التي كوَّنتها في طرق التهريب فأعمل كدليل وكجاسوسة.
تنتهي الحرب، لكنهم لا يعاملونني كبطل حرب، بل حُرمت من أي تعويض، ولم أحصل على معاش تقاعدي؛ ذلك لأنني امرأة سوداء، لكن متى كان المناضل يأبه للنياشين؟
أهب حياتي لحركة حقوق النساء في التصويت، ورعاية السود العجائز والمقعدين، إلى أن ينتهي أجلي سنة 1913.
الطريف أنَّه بعد قرن وثلاث سنوات من موتي يشعر الأمريكيون -أخيرًا- أنني أستحق التكريم؛ فيزينون بعض فئات الأوراق النقدية بها، كأني أُطل على الناس لأخبرهم أن المقاومة ممكنة.