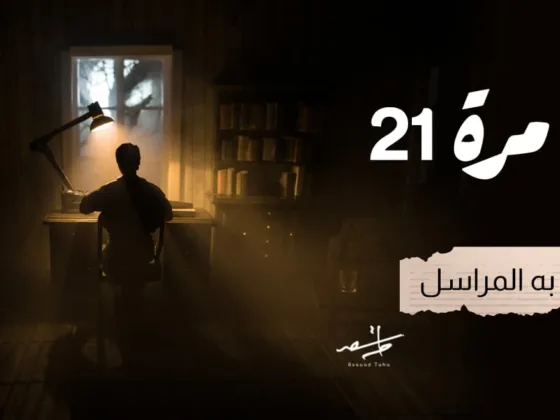(1)
ننتقد النشطاء الغربيين الذين يدافعون عن فلسطين، نرى أنهم لا يتبنُّون روايتنا بالكامل، نطلب منهم أن يكونوا عربًا مسلمين، أكثر منَّا، فإذا عالجوا الأمر من وجهة نظر إنسانية، قلنا: إن المسألة أكبر من ذلك.
وإذا دافعوا عن غزَّة، قلنا: ولماذا لا تتحدَّثون عن كامل فلسطين؟
وإذا أقدمت جنوب إفريقيا بطلبها المعروف للمحكمة الدولية، قلنا: ولكن هذا البلد يحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع الكيان!
كل شيء مرفوض، عملاً بمبدأ: كل شيء أو لا شيء.
لماذا نكفر بخطوط التماس بيننا وبين الآخرين، فنتعاون فيما نتَّفق عليه، ونجتهد في تبيان الحقيقة للآخرين؛ حتى تكبر الدائرة التي نتَّفق عليها؟
شكرًا لكل من يشارك في الدفاع عن المظلومين، وفق ما يستطيع، بحبَّات البرتقال التي رماها التاجر الصعيدي على الشاحنة التي علم أنها تحمل مساعدات إلى غزَّة، إلى الرياضي الذي رفع علم فلسطين في المحفل الدولي، إلى الأحرار في الغرب الذين يُزعجون الساسة الداعمين للإبادة فيطاردونهم في ندواتهم، ومطاعمهم، وفي حركاتهم اليومية.
أي شيء أفضل من لا شيء.
ولا ننسى أننا جميعًا مدانون -وبحقٍّ- من أهل غزَّة.
(2)
حادثة مشهورة وتتناقلها الألسنة.
الرئيس البوسني علي عزت بيغوفيتش يدخل متأخرًا إلى المسجد في صلاة الجمعة، فيوسع له الحاضرون طريقًا إلى الصف الأول، فيقول لهم: هكذا تصنعون طواغيتكم.
نحسب أن بيغوفيتش من الصالحين، رمز وطني وإسلامي وفكري عظيم، لكنه لا يريد تعظيمًا.
نفتخر بالأبطال، نضعهم في منازلهم المستحقَّة، ونقدر قدرهم، نحكي لأطفالنا عنهم، لكن في النهاية ندرك أنهم بشر، وإذا كان عطاؤهم يفوق عطاءنا، وإذا كان لا مقارنة بين ما يبذلون، وما نبذل، إلا إنهم يحتاجون نصائحنا، ولا أفهم حساسية البعض من أن توجه نصيحة لأحدهم!
فلسطين هي القضية، كل الأبطال الذين مضوا وكل الأبطال المعاصرين إنما كانت عيونهم صوب الهدف، فلنفعل فعلهم.
تحت القائد هناك ألف ألف بطل.
وخلف الكاميرات ألف ألف بطل.
وحكايات المجهولين ربما تكون أكثر دهشة من حكايات المعروفين.
لا نريد أن ننتقل من تأليه الحكَّام إلى تأليه الأبطال.
الأبطال أنفسهم لا يرغبون في ذلك.
ولذلك قال علي عزت بيغوفيتش قولته.
(3)
هل اشتد تبادل السباب على المنصات أم يُهيأ لي؟
من الطبيعي أن يعبِّر المرء منَّا عن رأيه، ومن الطبيعي أن يختلف معه آخرون، لكن من غير الطبيعي كمية وألفاظ السباب التي يردُّ بها بعضهم عليه!
إن الأمر لا يحدث تدريجيًّا، بل يقع الخلاف، فتبدأ الخشونة في الردود، ثم تتطور إلى ألفاظ بذيئة، بل ومن أول ردٍّ تُستخدم أقذع الألفاظ.
منذ متى أصبحنا هكذا؟!
ثم لماذا نحاكم الآخرين على نواياهم؟
مَن نحن لنحاكم الآخرين ما لم يعلن الآخرون صراحة عن ولائهم لعدونا؟
هل نُفرغ غضبنا المكبوت من عجزنا في سبِّ بعضنا؟
كل ما نفعله الآن ربما هو مؤشر لما سيصبح عليه حالنا في الغد.
تخيَّل أن هناك حوارًا ناضجًا بين الجميع، لا يُقصي فيه أحد أحدًا بأي سبب، ما لم يدعُ إلى التعامل مع الآخر بعنف، ما لم يهِنه.
تخيَّل حوارًا مع المقربين في دوائر خاصة، وحوارًا على المنصات، حوارًا بين الأفراد والمؤسسات، حول كل شيء، بعيدًا عن المؤسسات الرسمية، يُشارك فيه الجميع، نبحث فيه عمَّا بوسعنا أن نفعل، عن شكل الغد، عن مستقبل أبنائنا.
هل هذه أمنية مستحيلة؟!
ألا تعكس صدقنا، أو غير ذلك؟!
لقد علَّمنا الربيع العربي، أن سقوط الحاكم ليس مقياسًا على النصر؛ فقد أعد الأعداء ألف حاكم خلف الستار، فمتى وكيف نستعد للنصر؟
الوعي وصدقنا وجديتنا وحجارتنا يجب أن تظلَّ موجَّهة إلى الهدف الأكبر.
(4)
كنت أشعر أنني أعرف كنزًا لا يعرفه بنو قومي العرب.
صحيح أنهم كانوا يسمعون ويتابعون الحرب في البوسنة بكل حواسهم ودعمهم، لكنهم لا يعرفون الجانب الآخر من هذا البلد، هذا الجمال الساحر في المشهد، وهذه السكينة التي يشعر بها الزائر له، وما يصيب أرواحهم من راحة.
ثم بعد سنوات من الحرب، بدأ العرب يتدفَّقون على البوسنة للسياحة، فانتابتني الغيرة، وفي تناقض عجيب، فمن ناحية أريد أن تظلَّ هذه البلاد هي كنزي وهي مخبئي، ومن جهة أخرى أريد وصالاً بيننا وبين أهل البوسنة.
هذا التناقض في المشاعر وقعتُ فيه مرَّة مع حرب غزَّة.
فرح لدخول غير العرب في الإسلام.
وغيرة منهم لما يكتشفونه من كنز، لم نكتشفه نحن، بل غرقنا في الخلافات المذهبية، وفي الأمور الشكلية، وفي تجريم بعضنا البعض، بينما هم يصلون إلى لبِّ الأمر، وحقيقة الدين، ومعانٍ خفية علينا، بل ويعلن بعضهم أن الإسلام ليس دين العرب، وبالتأكيد محقُّون، العربية لغة القرآن، غير أن الدين لله على اختلاف ألوانهم وأشكالهم.
أفرح لدخولهم ديننا.
وأغير لوصولهم إلى ما لم نصل إليه.