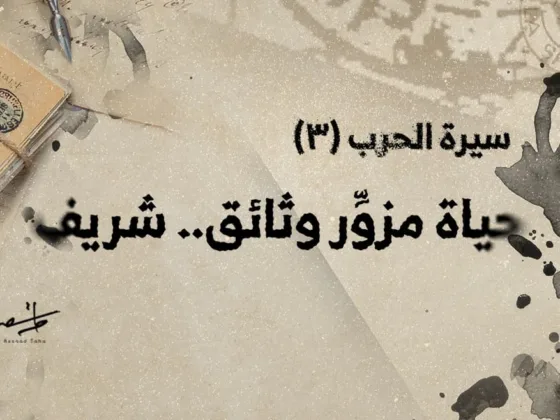(1)
اسمي سيفتلانا أليكسفيتش، قبل أن يحدث ما سوف أخبركم به، كنت أعمل محررة صحفية في الصحف المحلية لمينسك، عاصمة روسيا البيضاء، الخاضعة للاتحاد السوفيتي.
يومًا ما، وقد صحوت مبكرًا كعادتي، أحتسي قهوتي، وأتفحص الصحف اليومية، قبل أن أبدأ عملي، لكن في هذا اليوم -بالذات- لفت نظري عنوان رئيس يفيد بتكريم واحدة من أشهر المقاتلات الروسيات خلال الحرب العالمية الثانية، وتقليدها الأوسمة.
أفهم أن الصورة المراد تسويقها هو أننا بلاد المساواة بين الرجال والنساء، حيث جُند مليون امرأة سوفيتية؛ للمشاركة في الحرب جنبًا إلى جنب مع الرجال، لكني أدرك أن هناك جانبًا مخفيًّا من الأمر، تحديدًا حول ما فعلته الحرب في الناس، بل في النساء اللاتي شاركن فيها، وكيف دمرت حيوات الكثير منهن، فلتكن تلك مهمتي إذن.
(2)
تشتعل الفكرة في رأسي، وحتى أكتسب مصداقيتي، سأتخلى عن خيالي، وسأنقل شهادات من شاركن في الحرب بأنفسهن، وسوف أبدأ بمن تربطني بهن علاقات اجتماعية، ألتقي بهن في منازلهن، أترك لهن أن يقلن كل ما لديهن، تدلني كل واحدة على الأخرى؛ حتى أستطيع جمع أكبر عدد من الشهادات.
مع الحكاية الأولى يزداد يقيني بما أفعل، ألتقي بأخرى، فأجد لديها جديدًا، وهكذا واحدة إثر واحدة، كل واحدة منهن لديها الجديد، وكل واحدة منهن تدلني على الأخرى، لا أكتفي بمينسك مدينتي، بل أتنقل عبر المدن، في رحلة طويلة.
أكتشف أن العامل المشترك بين الكثير من السيدات، هو أنهن عشن قبل الحرب حياة يائسة وبلا قيمة، وكانت الدعوة التي وُجهت إليهن من الدولة للمشاركة في الحرب بمثابة نداء جعلهن يشعرن بقيمة أنفسهن، حتى إن بعضهن تركن أطفالهن؛ للذهاب إلى الحرب، لكنهن حينما عدن أقررن بأن الأمور لم تكن كما تخيلن؛ فحياة الحرب لم تحمل لهن المجد الذي سمعن عنه من الحكومة، بل وجدن فيها جماجم محطمة وجثثًا تنزف، وأيامًا طويلة من الجوع والعطش.
(3)
كان عملاً مرهقًا للغاية، بدأتُ فيه عام 1970 وبقيت حتى بدايات الثمانينيات أسجل وأوثق شهادات 800 امرأة التقيت بهن في عدة مدن، واستقبلتُ كميات ضخمة من الرسائل إثر إعلانٍ نشرتُه في الصحف أطلب فيه شهادة مَن شاركن في الحرب، مما منحني الأمل في تقديم عمل سيغير الصورة النمطية عند السوفيت عن النساء وحياتهن في الحرب، وبحلول العام 1983 أنتهي من نسختي النهائية من الكتاب، تحت اسم: “ليس للحرب وجه أنثوي”.
أعرض عملي على الناشرين، يرفضون المخاطرة بإغضاب السلطات، حتى أعثر على ناشر يقبل بالنشر شرط حذف بعض الأجزاء، فيخرج الكتاب بصورة غير مرضية، ولا يحصد الكثير من الشهرة والانتشار.
تعتبر السلطات السوفيتية أن الكتاب -وعلى الرغم من الاقتصاص الكبير في نصوصه، ومحاولة مراعاتي لمزاجية الحكومة- محرض على الدولة، ومشوِّه لصورة المرأة السوفيتية المناضلة، فتُصدر أمرًا بحظر نشره، وبعد عامين يُصدر جورباتشوف قرارًا بالموافقة على نشره تحت شروط مقيِّدة أفرغت الكتاب من الكثير من الشهادات.
أقابل الرئيس السوفيتي خلال فترة الثمانينيات، وقد قرر السخرية مني بصورة فجة عند ذلك اللقاء، فقال لي: تبدين صغيرة للغاية وضئيلة الجسم، كيف تكتبين هذه الكتب الكبيرة؟ فقلت له: أنت أيضًا لا تبدو عملاقًا، لكنك تستطيع تدمير إمبراطورية.
لم تمنعني هذه العقبات من أن أستمر، وفي عام 1985 أُصدر كتابي الثاني: “الشاهد الأخير”، أروي فيه حكايات من واقع حياة الأطفال السوفيت خلال الحرب العالمية الثانية، وما لاقوه من خوف وحياة قاسية بصحبة ذويهم داخل المعسكرات أو المدن أو حتى الملاجئ، لكن الحرب ضدي باتت مزعجة للغاية، فأقرر التوقف عن الكتابة عن الحرب.
(4)
حتى حل يوم من أيام عام 1986 كنت عائدة فيه إلى بيتي حين قابلتُ -بالصدفة- سيدة تلقت -لتوها- خبر عودة جثمان ابنها من الحرب في أفغانستان من الحكومة، فيما وصلتْ متأخرة -في نفس الوقت- الرسالة التي كان نجلها قد أرسلها، وهو يحكي فيها بتفاخر عن كونه جنديًّا مظليًّا في الجيش.
ثم جاءت واقعة ثانية حينما كنتُ في محطة الحافلات لأجد ضابطًا في الجيش قد جلس بجوار جندي نحيل للغاية وبؤبؤ عينيه ظاهر بوضوح وبجوارهما سيدتان من العجائز، فسألتُ عن الوضع لتأتيني الإجابة أن الضابط يقوم بمهمة توصيل ذلك الجندي إلى أهله بعدما أصابه الجنون، فقد كان في أفغانستان يحاول الحفر في الأرض بأي شيء يجده سواء كان شوكة أو عصا؛ حتى يحفر نفقًا يهرب به من أفغانستان إلى روسيا من جديد.
في الوقت نفسه بدأت تظهر أخبار في الصحف المحلية عن توابيت الزنك، تلك التي تعود فيها جثامين الجنود من الحرب في أفغانستان، حفزني ذلك للعودة إلى الكتابة عن الحرب، فأبدأ رحلة جديدة تستمر ثلاث سنوات أتنقل فيها بين أمهات الجنود وأسرهم؛ لأنقل عنهم الشهادات الخاصة بوقائع مشاركة أبنائهم في الحرب في أفغانستان.
أسافر إلى العاصمة الأفغانية كابول وأقابل مستشارين عسكريين روسًا وممرضات وجنودًا، ثم أعود لألتقي العديد من الجنود الشباب العائدين من الحرب أو زوجاتهم أو أمهاتهم، ليصدر أخيرًا عام 1989 كتابي: “فتيان الزنك”.
(5)
أحيا الآن في برلين بعدما رحلتُ عن مدينتي المحببة مينسك عاصمة روسيا البيضاء عام 2020 بعدما صار بقائي هناك مهددًا لحياتي بسبب رئيسها الديكتاتور، وأكتفي -بعد أربعين عامًا من الكتابة- بخمس كتب غيرت وجهة نظر العالم بأكمله عن الاتحاد السوفيتي الذي يعرفونه.
لم أكترث للدعوة القضائية التي رُفعت ضدي عام 1992، مِن قِبَل بعض من حصلتُ على شهادتهم، بضغط من السلطات، ولم أكترث لفوزي بجائزة نوبل عام 2015، وإنما أكترث دائمًا لأمر الحرب وبشاعتها، وأُصر بالكتابة على حرب الحرب، تلك التي تفقدنا أحبابنا، بل تفقدنا -أحيانًا- أنفسنا.