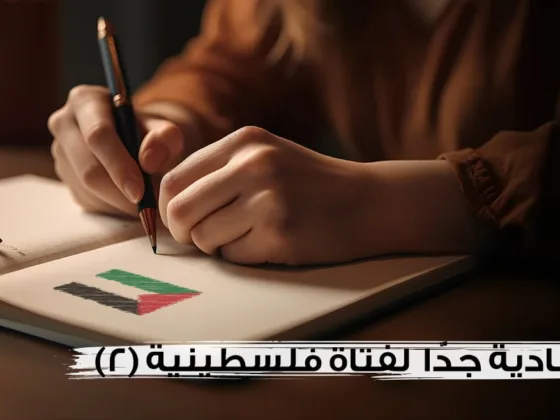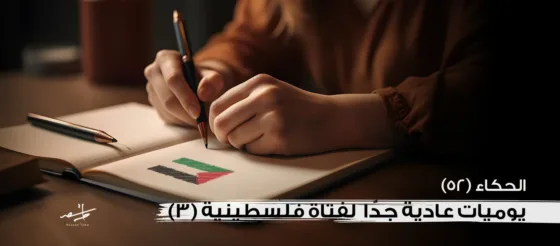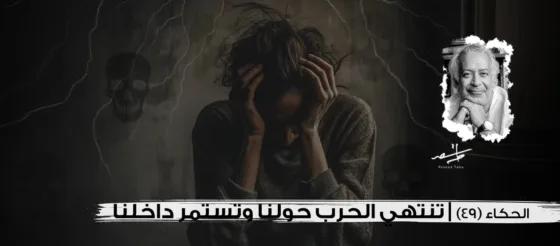(1)
الأول من آب أغسطس لعام 1990، أولد لعائلةٍ تتلهفُ لأول الأحفاد، وإن كانت أمنيات الجد والعمات أن أكون ولدًا، خصوصًا وأن العائلة فقدت أحد أبنائها شهيدًا، وتحاول أن تجد العوضَ في الأحفاد.
لم أشأ أن أضيِّع وقتي عبثًا، فبعد خمسة أشهر من ولادتي يُعتقل والدي، وأخوض أول رحلة إلى سجن الفارعة في جنين، تخبرني أمي أنها بكت كثيرًا في ذلك اليوم؛ لأنها لم تكن تتخيلُ أن تذهب بي وأنا طفلة رضيعة إلى ذلك المكان، خصوصًا وأننا لم ننجح في لقاء أبي؛ لأنه ساعتها كان قيد التحقيق، وممنوعًا من الزيارة، وعدنا مع جدتي، ونامت أمي وهي تبكي حزنًا وقهرًا.
(2)
تمر الأيام وأنا أُمضي طفولتي في حيِّنا الجميل بمدينة البيرة، البيوت فيها متلاصقة تزيِّنها الحدائق فيما بينها، يتنافسُ كل جارٍ على أن تكون حديقتهُ الأجمل، إلى أن حلَّ يوم كنت وإخوتي وأولاد الجيران نلعبُ أمام البيت، توقفت سيارة خضراء اللون غريبة لا نعرفها، وقفنا كلنا نراقبها، ينزل منها أشخاصٌ بلباسٍ غريب، يقترب أحدهم منا:
“وين دار ماجد حسن؟”
“شو بدك من بابا؟”
“إذا هو بالدار روحي ناديه واحكيلو صاحبك بدو إياك”.
دخلتُ إلى البيت وأغلقتُ الباب ووقف إخوتي وأبناء الجيران كحراسٍ صغارٍ أمامه، أخبرت أبي أن هناك شخصًا عند الباب يرغب في لقائه ويقول: إنهُ صديقك، وأتبعتها فورًا بجملة:
“بس -يا بابا- هو ما بشبه صحابك، ولابس أواعي غريبة”.
نظر إليَّ أبي نظرةً لا أنساها، ولم أعرف تفسيرها في حينها.
أمسكتُ بيده وهو يذهب إلى الباب، ولما فتحه سمعت الرجل صاحب الملابس الغريبة يقول له بأن يأتي معهم وبدون مشاكل، وقتها أجبتهُ أنا وقلت:
“وين بابا بدو يجي معكم؟”
“بدي نشرب معه فنجان قهوة وسيعود، والأمر لن يحتاج أكثر من خمس دقائق”.
حينها أمسكت بأبي ورحت أنا وإخوتي نبكي.
وفي لمح البصر انقضُّوا علينا مدججين بسلاحهم، اقتادوا أبي إلى السيارة الخضراء وأغلقوا الباب، سارت السيارة ورحت أنا أركضُ وراءها وأنادي عليه بأعلى صوتي، إلى أن وصلتُ إلى نهاية شارع بيتنا الطويل ووقعتُ على الأرض.
الخمس دقائق غدت خمسين يومًا في زنازين الأمن الوقائي، مر علينا فيها عيدٌ حزين قاسٍ، ثم شعرت أمي بوجع الولادة، فطلبت مني أن أُحضر حقيبتها وأتصل بصديقةٍ لها لتصحبها إلى المشفى، ذلك وللغرابة قابع أمام السجن تمامًا، الذي يضم أبي بين جدرانه، وفي هذه الليلة وفي غياب أبي ولدت أمي أختي شذى.
لاحقًا ذهبنا لزيارة أبي في سجنه، وبعد عودتنا بساعات، وجدناه يطرق الباب، وفسَّر الأمر بأن قرارًا صدر بالإفراج عن كل المعتقلين، وأتبعها بتنهيدة وقال: على ما يبدو أن هناك أمرًا سيحدث؛ لأنني سمعتُ من الضباط أنه تم طلب إخلاء المقاطعة -أيضًا- من كل العناصر الأمنية.
سكتت أمي وقالت بأنها ستعد العشاء لأبي، ونحنُ بقينا نجلسُ قربه وفي حضنه وفوق رقبته، نضحكُ ونلعب، لم يهمنا شيء في تلك اللحظة سوى أنَّ أبي قد عاد.
(3)
يوم الخميس الثامن والعشرين من الشهر الثاني لعام 2002، يعود أبي من العمل مسرعًا، لا يتناول الغداء معنا، لكن يضع في حقيبته بعضًا من أغراضه، يجلس في الصالة الكبيرة وينادي علينا بأسمائنا: تسنيم، عبيدة، شيماء، أمجد، شذى، محمد، وعبد المجيد، ثم يضمنا بحنان ويُقبِّلنا واحدًا واحدًا، يرجونا أن نطيع أمي ونسمع كلامها، وألاَّ نتعامل مع أيِّ أحدٍ لا نعرفه، وأوصانا بأن نخبر كل أحدٍ يسألُ عنه أنهُ مسافر، سلَّمَ على أمي وعمتي وخرج من البيت.
في تلك الليلة، قالت لنا أمي بأننا سننامُ في غرفةٍ واحدة، افترشنا الأرض، وحكت لنا عمتي حكاية ما قبل النوم، كانت قصة الشاطر حسن وإخوته، ورغم أننا نحفظها إلا أننا نحبُ أن نسمعها منها ولو كل يوم.
كانت الساعة تقتربُ من الثانية بعد منتصف الليل، حين تسللتُ من جانب أختي وذهبتُ أنظرُ من النافذة إثر سماعي لصوت رياح، الضبابُ في كل مكان، لا ضوء في الخارج، والجو مخيف، كنتُ أهُمُّ بالعودة إلى الفراش حين سمعتُ صوتًا، ثم أعقبه صوت رصاصٍ متواصل، ثم هدأ الحال.
ذهبتْ أمي إلى نافذة الصالة وأزاحت الستائر وفتحت طرف النافذة، فرأيت عدة أشخاص يحملون بنادق يجلسون مقابل البيت، على الأرض، وكأنهم ينتظرون أحدًا، أحدهم كان يُمسك جهازًا لاسلكيًّا، وفجأة انطلق الرصاصُ من بنادقهم، كان لهُ لونٌ أحمر كلما خرج، سحبتني أمي وأنا لا زلتُ أتعلقُ بالنافذة أريد أن أرى، جاء صوت رصاص آخر، لكن كان له وميض أزرق اللون، وكان من الجهة المقابلة، شدتني أمي وأجلستني على الأرض، وهدأ المكان لربع ساعة تقريبًا، قبل أن يعاود صوت الرصاص بشكل أعنف وأقوى، ثم نسمع صراخًا يملأ الحي كله، على ما يبدو بأن أحدهم قد أصيب، عدتُ إلى النافذة مرة أخرى وأمي تقول لي بأن أبتعد، وأخبرتها أن هناك أحدًا مصابًا، وأن الدم يسيل منه.
تهرع أمي إلى الهاتف لتتصل بالإسعاف، لكن لا أحد يجيب، بقينا نراقبهُ من النافذة وهو يحتمي بشجرة قريبة قبل أن يأتي شخصان آخران كانا رفيقيه على ما يبدو، ويحملانه ويغادرون المكان.
سَكَنَ كلُ شيء، إلا صوت المطر الذي ازداد، وقالت أمي بأنه يجب أن نعود إلى فراشنا وننام فلقد انتهى الأمر، لكن أسئلتنا الكثيرة لا تنام، حاولتْ أمي أن تفسر لنا الأمر، لكنها هي ذاتها لا تعرف ما يجري، فأخبرتنا بأن ننام وفي الصباح سنعرف من الأخبار.
ظلت أمي مستيقظة تراقبنا، وتظاهرتُ أنا بالنوم، ثم غفوت فعلاً قبل أن يعود صوت الرصاص مرة أخرى ويفزعنا هذه المرة، عندما اخترق باب الشرفة الخاصة بغرفة إخوتي، ويُحدث ثقوبًا فيه، أخذت أمي تسحبنا من أرجلنا، وتنادي على عمتي وتقول لها بأن لا ترفع رأسها وأن تخرج من الغرفة زحفًا، نادت أمي على عبيدة وأمجد وأيقظتهما وقالت لهما بأن يهبطا من فراشهما إلى الأرض.
لا أنسى منظر أمي وهي تحاول أن تحمينا جميعًا، سبعة نحن، صغار، فضلاً عن عمتي وأمي، كلنا ضممنا بعضنا البعض وجلسنا على الأرض نرتجفُ خوفًا وبردًا، ما الذي يجري في الخارج، كأنها معركة شديدة، صوت رصاص وقنابل، وصراخ بالعبرية والعربية، ونحن لا نعلم منه شيئًا.
ذهبت أمي وأحضرت لنا بعض الأغطية ولفَّتنا بها، وجلسنا كلنا على فرشة واحدة، وعلى ضوء صغير بعد أن انقطعت الكهرباء، ظل صوت الرصاص لساعة تقريبًا متواصلًا، واقترب الصباح ولم يُؤذَّن للفجر من مسجد الحي، كان أمرًا غير مسبوق، عللته أمي بانقطاع الكهرباء، وما إن بدأ النهار يطل من النوافذ حتى صمت صوت الرصاص، فحملت أمي وعمتي إخوتي الصغار إلى غرفتها، وأخبرتنا بأن من يريد النوم عليه أن ينام في غرفتها ولا يدخل إلى غرفة إخوتي.
نمت قرابة الساعة واستيقظت على صوت أمي وعمتي وهما ينظفان الغرفة، ويحاولان أن يستوعبا كيف دخل الرصاص من الباب وكيف تفتت فوقنا وبفضل الله لم يُصب أحد، أغلقت أمي فتحات الرصاص بورقٍ وأكياسٍ بلاستيكية؛ لكيلا يدخل الهواء البارد، وسجدت مرارًا لرب العالمين؛ حمدًا وشكرًا بأننا لم نصب بأذى.
(4)
اقتربت الساعة من الثامنة من يوم الجمعة، وبعد أن أنهت أمي وعمتي التنظيف قالت بأنها ستحضِّر الفطور عند استيقاظ باقي إخوتي، ولأنه لا كهرباء فلم نستطع أن نعرف ما الذي يجري من التلفاز، فاقترحت أن نسمع الأخبار من مذياع أبي الصغير، حيث كان معتادًا كل صباح أن يسمع الأخبار من إذاعة “صوت إسرائيل” التابعة للاحتلال، لكن باللغة العربية، ومنها يعرف أخبار الاعتقالات والاقتحامات بحسب ما يراه المحتل.
رحنا ننتظر موعد النشرة الإخبارية، وأمي تعد الفطور، وأنا أمسك المذياع وأقف قرب النافذة، وعندما حان موعد الأخبار عرفنا أن قوات الاحتلال اجتاحت الضفة الغربية، وأن الدبابات قد وصلت إلى وسط المدن الرئيسية، أغلقت أمي المذياع، وطلبت مني أن أساعدها.
كنت أضع بعض البيض لسلقه، حين رأيت جنودًا يخرجون من المبنى المقابل، ويمشون بأعداد كبيرة في الشارع، وقتها تلعثمت وخفت كثيرًا وبدأت أصرخ: “يهود.. يهود..”، أطفأت أمي الغاز بعدما رأتهم وركضت إلى إخوتي الصغار الذين كانوا نائمين، نادت عمتي وأخبرتها بأن اليهود أمام البيت، طمأنتني بأن الأمور ستجري على خير، لبست حجابها ووقفنا جميعًا خلفها وكأننا ننتظر قدومهم، وكأنها جدارنا الذي نحتمي خلفه، سمعنا صراخهم وطرقهم على أبواب الجيران، الذين لم يكونوا في البيت فقد كانت عادتهم أن يذهبوا للقدس كل يوم خميس، وعندما اشتد الطرق على بابهم، فتحت أمي باب بيتنا، وحوَّل الجنود بنادقهم صوبها، ونحن ننظر في ذهول وخوف، صاحت بهم أمي بأنه لا يوجد أحد في البيت.
اقتحم الجنود بيتنا وملابسهم متسخة بالطين ووجوههم ملونة بالسواد، أحدهم كان يرتدي فردة من حذاءٍ عسكري وأخرى من حذاء رياضي، يبدو أنه سرقها من إحدى البيوت.
سأل الضابطُ عمن في بيتنا فأشارت أمي لنا ولعمتي، وقالت: إن هناك صغارًا نائمين، فسأل الضابط: وأين زوجك؟ فقالت له بأنه مسافر، فرد الضابط، بأنهم سيمكثون في بيتنا؛ لنيل قسط من الراحة، ثم أمرونا بالجلوس في الصالة على الأرض، وجلسوا هم على المقاعد، وأحذيتهم العسكرية المتسخة بالطين وضعوها على سجاد بيتنا، وأخذوا مدفأة الغاز من أمام إخوتي الصغار، إنه بحق يوم طويل، لا يبدو أنه سينتهي على خير.