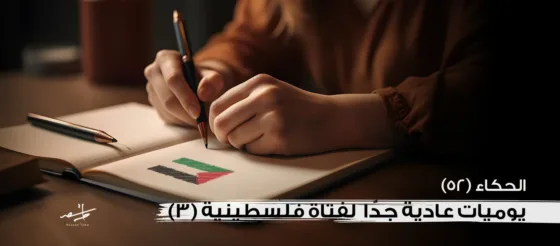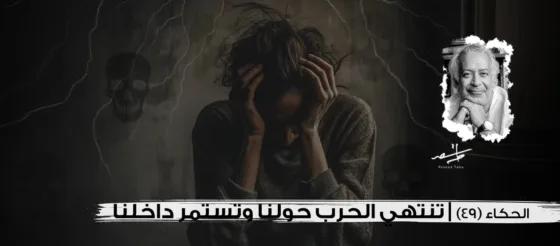لراغبي الهجرة:طريق أبو خليفة – (1)
(1)
تقرر أن تغامر، تحسب حساباتك، وتنطلق بحثا عن المتعة أو النجاح، أما أنا فلم أفعل، لقد فُرضت المغامرة علي فرضا، وكل ما كنت أتمناه هو الحياة، وإليكم التفاصيل.
(2)
4 آلاف يورو، هذه كل ثروتي، كل ما أملكه من حطام الدنيا، قدمتها إلى “أبو خليفة”، كي يؤمن لي طريقا إلى ألمانيا، لعلي أحظى بلجوء سياسي.
في الصباح الباكر تنطلق الحافلة من إسطنبول التي قدمت إليها من بلد خليجي لفظني، 9 ساعات تمر لأصل إلى أزمير، أتصل بالرجل، يرسل لي “كريم” بعد ساعة، يحملني بسيارته حوالي ساعة أخرى إلى أحد أطراف المدينة.
البيوت جميلة ومتباعدة، تغيب الشمس ويبدأ المطر بالسقوط، نتوقف عند بناية حديثة، أحمل حقيبتي وأنزل، من نافذة في الطابق الثاني ثَمة من يراقبنا.
أدخل الشقة المتواضعة والباردة، ألمح أحذية كثيرة لأطفال متناثرة على الأرض، يستقبلني رجل طويل تجاوز الـ60 من العمر، ذو شعر قليل أبيض، يصافحني بحرارة، “أهلين خيوي، أهلين أنا أبو خليفة”.
يجلسني في غرفة الضيوف، ويقدم لي القهوة، الكثير من البطانيات تحتل ركنا في طرف الغرفة، وكذلك العديد من الحقائب الفارغة، والكثير من علب السجائر.
تأتي طفلة صغيرة جميلة كأنها عنصر استطلاع ترغب في اكتشاف الضيف الجديد، ثم يليها طفل يكبرها قليلا يحمل بيده أطباقا من الطعام، يضعها على مفرش قد جهز من قبل، أنا فعلا جائع للغاية.. لكن للنوم، يلحظ أبو خليفة بسهولة الإرهاق المتمكن من وجهي، يسرع بتجهيز مكان لي للنوم.
ينتصف ليل أزمير، يتسلل ضوء بصعوبة من طرف النافذة، أشد على جسدي أكثر من بطانية اتقاء لهذا البرد، وأستسلم للنوم، إلى أن أستيقظ مبكرا على صوت الرجل، وهو يجري مكالمة مع أحدهم من غرفتي.
يأتي ابنه بالإفطار؛ بيض مقلي، وجبن، وزيتون، وزعتر، وزيت زيتون، والكثير من الشاي، لتبدأ بعدها محرقة السجائر، ما إن ينهي الرجل واحدة حتى يبدأ بأخرى “شوف خيو.. أنت تطلع من هون على اليونان”، أستوقفه يسرع بالرد “أبوس روحك خليني أكمل”،”تفضل”، “أنت بتطلع من أزمير لجزيرة في اليونان بقارب مطاطي، وبعدين بيجي يخت بيوديكم لإيطاليا، وبعدين يقابلكم واحد يركبكم القطار على ألمانيا”،”كم عددنا؟”، “شي 20 واحد.. ممكن الفلوس”،”ممكن أدفع النص، ولما أوصل أدفع الباقي؟”،”شوف خيو.. أنتم بعد ما تصلوا ما بتردوا علي، وأنا ما بآمن إلا والمصاري في جيبي”.
أعطيه المبلغ كاملا، لا يبقى لي إلا ملابسي وأفكاري، يعدني بالتحرك في غضون 10 أيام أبقى خلاها في هذا البيت.
ممنوع الخروج تفاديا لأي موقف مع الشرطة، يمر اليوم الواحد بصعوبة، إما منشغلا بهاتفي أو أحكي قصصا للأطفال الـ3، أكبرهم 7 سنوات واسمه لورانس، وفاطمة 5 سنوات، وسناء 3 سنوات، وفي الليل أحاديث المساء مع أبو خليفة.
يمر أسبوع وبعده أسبوع، يبرر الرجل التأخير بالطقس والتشديد الأمني، الملل سيد الموقف، ينقضي 25 يوما كاملة، ثم بالقرب من مغرب أحد الأيام يدخل أبو خليفة الغرفة فجأة، ليخبرني أننا سنتحرك في الغد، يهديني حقيبة تُحمل على الظهر طالبا التخفيف من حمولتي، والتخلص من حقيبتي، ومن كل ما يمكن التخلص منه.
أكتفي بصابونة، وفرشاة أسنان، وبطارية شحن للهاتف، ومنشفة، وأوراقي المهمة، والقليل جدا من الملابس، أفكاري وتساؤلاتي لا تمكنني من النوم: هل سننجح؟ هل سيقبض علينا البوليس التركي، أم ستأكلنا الأسماك في عرض البحر؟
في الـ6 صباحا يدخل أبو خليفة الغرفة، يبدو أنه لم ينم أيضا، تبعه ابنه بالقهوة،”في ناس بيجو لهون، وبعدين في سيارة بتيجي تاخدكم، وأنا لحد هون وبس، وبعدين بتكون مع واحد اسمه أبو جهاد، ولو شيء صار معكن والتغت العملية بتركب تاكسي، وبترجع لهون لحالك”،”يعني في احتمال تلتغي العملية؟”، “إيه ممكن كتير، بس لا تاكل هم”.
يزداد توتري، تبدأ طبول الحرب تضرب داخل القولون، وكان وزني قد زاد في تلك الليلة، فقد لبست من كل شيء 2 حتى أقلل وأخفف من وزن حقيبتي، يدق جرس الباب، يفتح أبو خليفة الباب، تدخل فتاة لم تتجاوز الـ20 من عمرها، تلبس جينز وبلوزة، وتحمل معطفا على يدها، وحقيبة هي أقرب الى أكياس الهدايا، شعرها طويل، لا تضع أي مساحيق، لا أشم رائحة أي عطر، إذن فهي ضمن المهمة المستحيلة.
تقترب مني وتصافحني، “ها خيو، آمال من سوريا بتكون معكن، دير بالك عليها”، “أتمنى أن أكون عند حسن الظن”. يذهب أبو خليفة، تنشغل آمال بهاتفها، أسألها فتجيب: “هذه المرة الـ5، فكل مرة يقبض علينا البوليس البحري التركي ويحجزنا لمدة 20 يوما ثم يخرجنا”، “يخرجكم إلى أين؟”، “إلى سوريا، لكني أخبرهم أني فلسطينية، وقد أضعت جواز سفري، فيفرجون عني بعد توقيعي تعهدا أن أغادر تركيا خلال شهر، ثم أعيد المحاولة”.
يدخل مهربنا حاملا صينية الشاي، يدق جرس الباب، يدخل رجل طويل يرتدي أشياء متناقضة جينز، وتي شيرت، ومعطف بدلة رسمية. وتنبعث منه رائحة السجائر، سوري اسمه أحمد.
بعد قليل نطيع التعليمات ونغادر البيت، لنستقل سيارة تقف أمام البيت بسائقها التركي، لساعة يقود بنا السائق دون أن نتبادل الحديث وفق أوامر أبو خليفة، نعبر وسط المدينة، وندخل في حي قديم شوارعه ضيقة، ما زال أحمد نائما، لكن آمال تصيح “نحن في حي البصملي، وأعرف البيت الذي سننطلق منه”.
أمام بيت قديم توقف السائق وأمرنا أن ننزل بسرعة، يرحِّب بنا شاب لم يتجاوز عمره 15 عاما، يجلسنا في غرفة بها أرائك مهترئة غير نظيفة، الساعة تقترب من الـ10 صباحا، أحمد يكمل نومه، وآمال تدفن رأسها في هاتفها.
بعد قليل يدخل الشاب الذي عرفنا أن اسمه خليل، ليبلغنا أننا سوف نغادر بعد ساعتين، يدلني على غرفة أخرى بها 3 من الشباب، أحدهم هيئته عراقي، بشارب كبير، سألت الشابين الذين بدا أنهما أخوين “هل تتكلمان العربية؟” يرد أحدهما ضاحكا أنا من اليمن، وكنت أعيش في جدة، لا أستطيع العودة لبلدي، وتحرمني الأوضاع الحالية من البقاء في السعودية. سألته منذ متى وأنت هنا؟ أجاب منذ يومين، أما محمد العراقي فقال إنه في هذا البيت منذ شهر.
تمر ساعتان وأنا أراقب عقارب الساعة، أتمنى مغادرة هذا المكان الذي بدا لي كبيت للأشباح، بظلمته ورائحته الكريهة، في الواحدة ظهرا يدخل خليل فجأة ليخبرنا أن الساعة قد حانت.
وقفت أنا وأحمد وآمال في الممرِّ بحسب التعليمات، كل منا يمسك أمتعته، يأتي رجل بلحية كثيفة، حليق الرأس، تلتف على رقبته سلسلة غليظة، يرتدي في أصابعه عدة خواتم، مرسوم على رقبته وشم، وتسبقه رائحة السجائر.
أمرنا أن نخرج: “إذا قابلتكم الشرطة قولوا لهم احنا أصحاب وطالعين نتمشى على البحر”. ينطلق السائق وهو سوري هذه المرة، من شارع إلى شارع، حتى خرجنا من أزمير إلى بودرم، أحمد نائم، آمال على هاتفها، السائق لا يكف عن التدخين.
بعد ساعة نتوقف عند محطة للوقود، يطلب السائق أن ندخل إلى سوبر ماركت بجانب المحطة لنشتري أي شيء، ثم نخرج ونتجه لسيارة أخرى أشار إليها، فعلنا ما أمرنا به، كنت أتتبع آمال معتمدا على خبرتها السابقة، ركبنا السيارة الأخرى، قلبي يدق بسرعة، أشعر أنني في خضم فيلم بوليسي، يأتي رجل يلقي التحية ويقود السيارة.
بعد نصف ساعة تقريبا ندخل قرية جميلة، نتوقف عند منزل ونؤمر بالنزول، قلقي وخوفي يزدادان، عدة سيارات في مواجهة البيت، أطفال يلعبون، ترحب بنا امرأة سورية، ندخل غرفة بها شباب من ضمنهم الـ3 الذين التقيتهم مؤخرا، وألمح نساء وأطفالا في غرفة مجاورة.
يدخل رجل سبعيني، يرحب بنا، يجلس بجواري، يسألني عن اسمي، وعن الرجل الذي أرسلني ودفعت له، ثم يفعل الأمر نفسه مع الجميع، إلى أن يدخل رجل ويأمرنا أن نستعد للمغادرة، أجلس في المقعد الأمامي، تجلس خلفي 4 فتيات من ضمنهن آمال، تتبعنا 3 سيارات أخرى حملت من حملت من سكان البيت.
يفتح رجل باب السيارة ويعطيني طفلة في الـ5 من عمرها: “خليكي هون مع عمو”، ثم يجلس هو يقود السيارة، يطلب منا إغلاق هواتفنا، يتعمد الخروج من الطريق الرئيسي، ويقود عبر الطرق والممرات الفرعية بين القرى والمزارع، طرق معبدة سلسة لكنها ضيقة نسبيا، فيما رائحة روث الحيوانات والأسمدة الزراعية تهب قوية.
حاولت أن أُطمئن نفسي وأصطنع الشجاعة واللطف، أقضي الوقت محاولا ملاعبة الصغيرة روان بشعرها الطويل الذي يعبث به الهواء، تمر ساعة تقريبا، ونحن من قرية إلى قرية، ثم أخذ الطريق يضيق أكثر فأكثر، لا تتبعنا السيارات الأخرى، لكنها بحسب السائق ستلحق بنا في مكان آخر.
ثم فجأة نجد أنفسنا وجها لوجه مع سيارة للشرطة التركية، إذن انتهى أمرنا، توقف الزمن تماما، سوف يلقون القبض علينا ويرحلوننا، ثم وبدون مقدمات تتراجع سيارة الشرطة وتسمح لنا بالعبور، نتنفس الصعداء.
ربع ساعة تمر، يظهر البحر أمامنا، من خلف جبل يفصلنا عنه، يتوقف سائقنا، يخرج رجل من بين الأشجار ويشير لنا بيده، يخبرنا السائق أن نغادر السيارة بهدوء، نتبع الرجل إلى داخل الغابة، الساعة تقترب من الـ4، نمشي بحذر في غابة وعرة، إلى أن نجد فجأة مجموعة من الناس تفترش الأرض، ربما أكثر من 20 رجلا فضلا عن النساء والأطفال.
ممنوع التدخين إلا من تحت المعطف، ممنوع العبث بالهاتف، ممنوع الكلام إلا همسا، هكذا كانت الأوامر، تغيب الشمس، نشعر ببعض البرد، أكتشف أن الموجودين من اليمن والصومال والسودان وسوريا وفلسطين والعراق ومصر، إذن جامعة الدول العربية هنا.
يتملكني الخوف من أمرين: أن يُقبض علينا بعد كل هذا التعب ونسجن، أو أن تهجم علينا الخنازير البرية الوحشية التي تنتشر في غابات تركيا، هدوء تام إلا من صوت طفل يبكي بصوت مخنوق، وكأن أمه دفنته في حضنها، أو من صوت تكسير أغصان يابسة تحت قدم أحدهم يتحرك ببطء، الظلام دامس، وممنوع إشعال أي نوع من الأضواء ولو عود ثقاب أو ولاعة، لكن السماء صافية، يأتي رجل يوزع علينا الماء والتمر.
الوقت حوالي منتصف الليل، نشعر بحركة غريبة على مقربة منا، يظهر رجل يقول بصوت منخفض: “يالله يا جماعة واحد واحد ورا بعض وخليكن وراي”. حاولنا أن نسير صفا لكن هيهات، فالظلام دامس والرؤيا شبه معدومة، كان صوت تكسير الأغصان اليابسة تحت أقدامنا كالصراخ، كدت أسقط عدة مرات.
نصل إلى الشاطئ، النساء والأطفال سبقونا إلى هناك، نلمح عن بُعد أضواء خافتة، يقول لي أحدهم “تلك هي اليونان، جزيرة كوس تحديدا”، أسأله كيف عرفت؟، “هذه 3 محاولة لي من نفس النقطة”.
ألتفت خلفي على إثر أصوات أقدام متسارعة، مجموعة من الأشخاص يحملون قاربا مطاطيا لونه أبيض، يضعونه في البحر، يبدأ الناس بالركوب، يسأل أحدهم عن سترات الإنقاذ، يجيبه أحدهم بحزم “ما في ولا أي شي، اللي بدو يكمل الله يسهله، واللي ما بدو يضل هون ويرجع معنا لأزمير”.
أشعر أنني أنهار من داخلي، في حالة الغرق لا أمل ولو ضئيلا في النجاة، يعترض البعض ويقرر البقاء قبل أن يتراجع لاحقا، يأتون بمحرك، ويحاولون تركيبه، أجلس بمقربة منه، أمامي شاب في الـ20 من عمره، هو من سيقود هذه الكتلة المطاطية البالونية، أضع حقيبتي بين ركبتي وأجلس على طرف القارب، فيما الأطفال في وسط القارب، يبلغ عددنا في هذا التابوت العائم 45 شخصا شباب وعجائز، نساء وأطفال.
رائحة الوقود نفاذة، الشاب يحاول تشغيل المحرك، يقوم 4 أشخاص بدفع القارب للأمام، يختلط صوت المحرك بصوت أمواج البحر، التي تصفعها مراوح المحرك، ترتفع أصوات الرجال الـ4: “الله معكن، الله معكن”
يتوقف المحرك فجأة، يفشل الشاب في تشغيله، ويصرخ “العمى شو أسوِّي؟”، يحاول بعض الركاب التدخل، ينفعل أكثر “كل واحد يخليه مكانه، ويخلي لسانه في فمه”، ينصحه أحد الـ4 الذين على الشط، ونحن لم نبتعد عنهم إلَّا عدة أمتار “ولك انفخ فيه.. انفخ فيه”.
يقوم السائق بفك قطعه بلاستيكية من المحرك، وينفخ فيها ثم يعيدها إلى مكانها، فيدور المحرك، يجلس بيني وبين السائق في حوض القارب رجل غطى نفسه ببطانية، ومعه هاتف يتابع “جي بي إس”، يرشد السائق: “ولك يمين شوي، روح يسار، أي هيك منيح”، بعد قليل يرد عليه السائق: “ولك خلّص عارف طريقي”.
كان البحر هادئا جدا، كأنه سجادة سوداء كبيرة، والسماء صافية، والنجوم قطع ألماس معلقة ومتناثرة، أخذت أضواء تركيا تبتعد شيئا فشيئا؛ لكن ذاك الضوء البعيد القادم من اليونان يبدو لي كأنه لا يقترب أبدا.
من حين لآخر يهتف فينا السائق “قولوا يا الله”.. ويرد عليه الركاب “يا الله”، كان بعض منهم يرفع يديه إلى لسماء، والآخر يلتفت يمنة ويسرى بحركة بطيئة كأنه يستطلع المكان، وآخرون منشغلون بأطفالهم، أما أنا فقد كنت أراقب كل شيء، خصوصا أنها أول مرة في حياتي أركب فيها قاربا.
فجأة يتعطل المحرك مرة أخرى، يسود القلق الجميع، يدور القارب حول نفسه عدة مرات، ثم يستقر عكس وجهتنا، قبل أن ينجح السائق في إعادة تشغيل المحرك وتعديل الاتجاه ومواصلة الرحلة.
صوت غريب يأتينا من تحت القارب، يقلل السائق من السرعة، ثم يبدأ الصوت في الاختفاء، لا أحد يفهم ماذا يجري؛ لكن الرحلة ما زالت مستمرة.