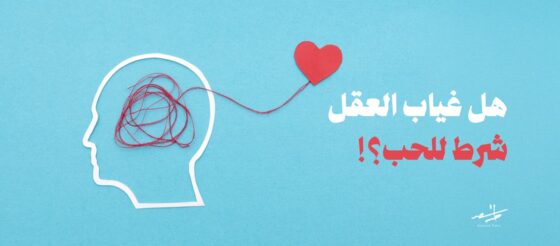(1)
كبرت، وكبرت معي فلسطين.
تلميذًا في المرحلتين الإعدادية والثانوية، كانت رفيقتي في الإذاعة المدرسية، وفي صحف الحائط، عالقة في ذهني، وفيما أكتب وأقول، ولا يمكن وصف سعادتي، حين نشرتْ مجلة “الأشبال” الصادرة عن المقاومة من لبنان رسالة بعثتُ بها إليهم، لقد مشيت يومها بخفة في شوارع مدينتي التي هُجِّرت إليها بعد نكسة 1967 وكأني “ياسر عرفات”، ولما لا؛ فقضيتنا واحدة؟!
لكنها ، أي فلسطين، ستكون محك الخلاف الرئيسية مع السادات وهو يوقِّع “كامب ديفيد”، وفي المهرجان الجامعي وفي حضور كبار القوم تجرأ أحدهم وامتدح في خطبته المعاهدة الملعونة، وشبهها بصلح الحديبية، فلم أستطع إلا أن أرد عليه مستغلاًّ أنني أدير الحفل، وأملك الميكرفون: “أستاذي القدير، فارق كبير بين صلح الحديبية التي فتح بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة المكرمة، وبين صلح كامب ديفيد الذي رفع لليهود راية فوق مصر المسلمة”.
صحيح أُقر للسادات بذكائه السياسي، خصوصًا إذا قارناه بزعماء هذه الأيام، لكن لم أغفر له في نفسي هذه الخطوة أبدًا.
(2)
نعم كبرت وكبرت معي فلسطين، حتى وإن كانت مساحتها الجغرافية تقلصت.
ثم كانت هذه الفرصة التي هيأها لي “حزب الله”، قبل أن تتعثر بنادقه؛ ففي جبهته مع العدو الصحيح كنت أمارس مهنتي صانعًا للأفلام الوثائقية، حين وعدني مرافقنا من الحزب على تصوير حيٍّ لمعركة مع العدو.
وفي الموعد المحدَّد، كنا نعتلي مرتفعًا، وحولنا جنود المقاومة، ومعي زملائي من الفريق، حين شاهدتُ العَلَم البغيض الذي سبق وشاهدته مرفوعًا على الضفة الأخرى من قناة السويس، وجدته هناك عن بُعدٍ مرفوعًا على ثكنة لهم، ثم يُصدر القائد بجانبي أوامره عبر جهازه اللاسلكي، فتنهال القذائف على ثكنة العدو، ويسقط العَلَم، وأشاهد جنوده يفرون.
كنت في قمة سعادتي، ورجال الحزب من حولي يظنون أن ذلك لحصولي على هذه المادة التي لم تُمنح لصحفي آخر، فيما كنت -أنا- سعيدًا لثأرٍ شخصي؛ فقد عشت مع عائلتي أيامًا صعبة حين كانت طائرات العدو تقصف مدينتي السويس، وقبل أن يفي الجيش المصري بوعده بعبور القناة.
تمر الأيام ويندلع الربيع العربي، وتملأ أخباره العالم كله، يميل على أذني صديق ويقول لي مازحًا: راحت عليك؛ فلسطين تتوارى وسط هذه الثورات، ولن يهتم بها أحد في الفترة المقبلة، سوف ينكفئ كل شعب على قضيته إذا انتصر وأسقط نظامه، أو إذا هُزم.
خالفته الرأي؛ إذ كنت أرى وما زلت أن الكيان وراء كل أذى يصيب المنطقة، وللأسف لم يخب ظني؛ فقد استمدت كل الثورات المضادة وكل الأنظمة التي حاربت الربيع قوتها من هذا الكيان، وكل من يريد أن يستقوي على شعبه إنما يستقوي بهذا الكيان المزروع غصبًا في أراضينا.
(3)
في وقت مبكر من عمري قررت أن أجعل فلسطين معلمي.
أمر يتجاوز الأخبار والتحليلات والآراء.
ابتسامة الأسير الفلسطيني تقهر عدوه، يُلقى القبض عليه فيبتسم، يقضي في السجن سنوات، ثم يخرج، ثم لا يتوب، ثم لا يبقى صامتًا، ثم يُعاد إلى سجنه فيبتسم، أفعل مثله في حياتي كلما وقعت بي مصيبة، أو مررت بضائقة، أبتسم وأمضي.
يقولون: إن ميزان القوى يفيد بأنه لا أمل، وإن بعد الحسابات والدراسات وتقارير الذكاء الاصطناعي فإن هذا الكيان جاء ليبقى، ويقولون ويقولون، والفلسطيني لا يعبأ بذلك كله، يستمر في نضاله ببساطة وعزم غير عاديين، بحجر أو صاروخ، أو هتاف، بأي شيء هو مستمر، وواضح أنه ينظر إلى الأمام، وأنه يرى شيئًا نحن لا نراه، وهو يفعل ذلك مدركًا أنه قد لا يحصل على الجائزة في حياته، وأنا بت في حياتي الشخصية أفعل مثله، أومن بالفكرة، أناضل من أجلها، يسخر الساخرون، يضعون العراقيل، وأنا مستمر في طريقي، لا أتلفت.
يدرك المناضل الفلسطيني أنه قد لا يصل، لكن أمره عجيب، إنه يستمر بنفس الحماس، مؤمنًا بأن نجاته الشخصية في أن يفعل، بغض النظر عن النتيجة، وأنا أتشبه به، أمضي في طريقي الذي أرى أن عليَّ أن أسلكه، وبغضِّ النظر عن النتيجة.
فلسطين ليست وثنًا، فلسطين تحطِّم الوثن، ولذلك أحبها، ولست وحدي، فنحن كثر ونزداد، بل أرى أن في عالمنا هذا المحكوم بقوى عظمى هناك مَن بدأ يخرج عن السيطرة، يفهم قضية فلسطين ويرفع شعاراتها، أحيانًا مبادرات فردية، وأحيانًا جماعية، لكن في كل الأحوال فإن الأمر يتغير، وإن نصرة فلسطين تكبر، وإن كان رجال المقاومة قد كفروا بكل شيء سوى سواعدهم بعد إيمانهم بمشيئة الله وقدرته.
(4)
ذكرى لا أنساها وأنا ابن التاسعة.
طاولة صغيرة، أجلس على طرفها، وفي مواجهتي جارتي “سيدة”، هي طفلة في نفس عمري، الأستاذ صالح يتوسطنا، يعلمنا الرياضيات، المادة التي لا أحب، لكن أحببت أنه من فلسطين.
في سني المبكرة هذه علَّمني أبي “فلسطين”، ورأيتها مكتوبة على جدران الشوارع، وسمعتها هتافات من أهل مدينتي الواقعة هناك على مدخل القناة التي يعرف العالم اسمها جيدًا “السويس”، فضلاً عن خطابات عبد الناصر التي تعدنا بأننا في الطريق إليها.
لكنني كرهت “صالح”؛ لأنه شخص يائس، كافر بالعروبة، يقر بالهزيمة، ويسخر من المقاومة، لا يمل من تكرار جملته البغيضة عن بلاده: “أولها فَلَسٌ وآخرها طين”.
طلبت من أبي أن أتوقف عن هذه الدروس وعن هذا المدرس، واستجاب لأمنيتي، لكن عبد الناصر لم يستجب، وما هي إلا عدة شهور ووجدنا جيش الكيان على حافة القناة، واضطر صالح أن يهاجر مرة أخرى، معتقدًا أنه على حق فيما يعتقد.
غير أن الدرس العظيم الذي تعلمته في هذا السن المبكرة ما زال معي حتى الآن، يمكنك أن تكره شخصًا يحمل فكرتك، لكن لا تكره فكرتك.