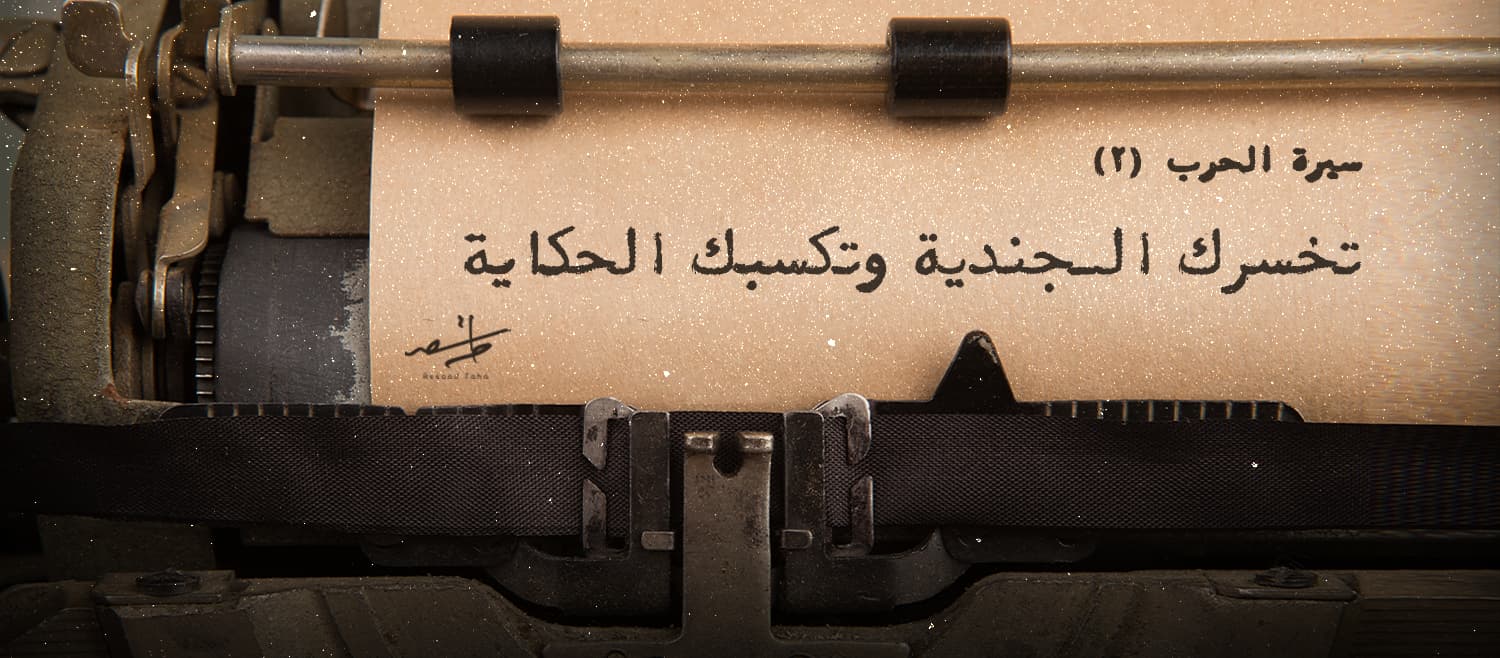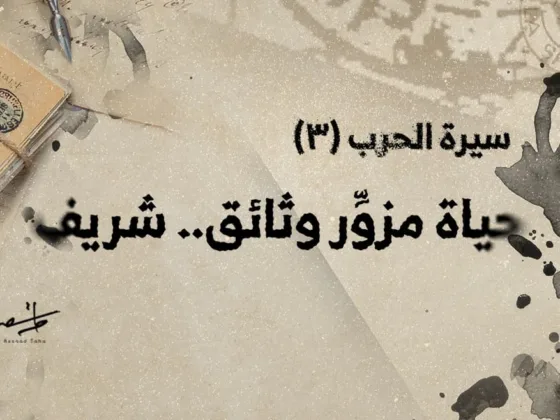(1)
غريبٌ أمر هؤلاء الراغبين في الذهاب إلى حيث تكون الحرب، إنها لم تُفرض عليهم، لكنهم -باختيارهم- يرغبون في الذهاب إلى هناك، ربما يتخيلون أنها مغامرة تدفع الأدرينالين إلى العروق، أو ربما لمتابعة حية لحدث تاريخي لا يتكرر، لكن المشكلة أن صاحبنا -وبعد أن حاز على الأدرينالين، وكاد أن يموت- قرَّر العودة مرة أخرى إلى الحرب، وإذا كان مراهقًا في الأولى، فإنه رجل ناضج في الأخيرة، لكننا نعذره؛ على الأقل قدَّم لنا ما يستحق.
(2)
يبلغ صاحبنا الأمريكي الثامنة عشر من العمر في العام 1917، أي: العام الذي انضمت فيه بلاده إلى أُتُّون الحرب العالمية الأولى، وإذا كانت رغبته في المغامرة هي التي دفعته للتطوع مقاتلاً في صفوف جيش بلاده، بعد أن كان يعمل مراسلاً صحفيًّا، فإن الاختبار الطبي حال دون ذلك، ليغادر الوحدة العسكرية جارًّا أذيال الخيبة، فقلبه معلق بفكرة السفر إلى مناطق الحرب.
يتوجَّه بعدها إلى هيئة الصليب الأحمر متطوعًا، يُعين كقائد سيارة إسعاف، ويُرسَل إلى ميلانو الإيطالية، وهناك تضرِب قذيفة سيارته، ويُصاب إصابة بالغة، “انفجر وميضٌ فجأة كما لو أن باب فرن انفتح ليخرج من خلفه اللهيب، كان لونه أبيض، ثم تحوَّل للأحمر”.
(3)
يستيقظ في مشفاه، تتفتح عيناه على الممرضة بنت بلده أجنيس فون كروفسكي، ومثل الأفلام الأمريكية، يقع في حبها، وبعد عدة شهور تنتهي الحرب فينطلقان يقضيان وقتهما معًا هنا وهناك، ليبدو واضحًا أنهما على وشك الزواج.
لكن الفتاة يصيبها القلق؛ فقد لاحظت أن فتاها يتغير بسرعة؛ فقد أصبح واثقًا في نفسه أكثر من اللازم، إلى الحد الذي بات مهتمًّا بنفسه بشدة، وغير مبال بالآخرين، يدفعها هذا الشعور إلى التردد في فكرة الارتباط به.
ثم فجأة يخبرها ذات يوم أن عليه أن يرحل عائدًا لبلده؛ لزيارة والديه، تبلِّغه هي الأخرى أنها كذلك سترحل عن ميلانو، وقد كانت تلك لحظة فراق غريبة، فقد انتهت على إثرها قصة حبهما القصيرة، فلم يقابل أي منهما الآخر بعدها، ولم يتراسلا، وليَعلم لاحقًا أن فتاته قد وقعت في حب رجل آخر، وقررت أن تكمل حياتها معه، لتكون تلك تجربة قاسية أخرى بعد تجربة الحرب، فيقرر كتابة روايةٍ يستقي أحداثها من قصة حبه القصيرة مع أجنيس وتصدر الرواية باسم: “وداعًا للسلاح”.
(4)
في سبتمبر/أيلول من عام 1922 كان صاحبنا موجودًا في العاصمة الفرنسية باريس حينما عَرض عليه محرر صحيفة تورنتو ستار القيام بتغطية صحفية من داخل جبهة الحرب التركية اليونانية، ليدخل جبهة حربية -لأول مرة- كمراسل صحفي.
سجَّل مشاهداته في الحرب وهروب اللاجئين من كلٍّ من تركيا واليونان.
ثم مضى وقت طويل -منذ تلك المعركة- حتى حلَّت الحرب الأهلية الإسبانية، وقد كان في تلك الفترة على موعد مع زواجه الثاني من الصحفية اللامعة مارثا جيلهورن صاحبة كتاب “وجه الحرب”، وقد كان اهتمامها الكبير بإسبانيا وشغفها بتغطية المواجهات هناك سببًا في جذبه إلى تلك النقطة من العالم.
عاصر الرجل وزوجته بدايات الصراع في إسبانيا في فندق شبه سري في العاصمة مدريد، وأرسل كلٌّ منهما تغطية صحفية للجريدة التي يعمل بها حول الحصار الفاشي للحكومة الجمهورية الجديدة، والقصف العنيف للعاصمة، وشكَّل كلاهما معًا ثنائيًّا غاية في التميز من الناحية العاطفية والناحية الصحفية في قلب الحرب.
سجَّل في ذاكرته ما يكفي من الأحداث والشخصيات التي شاهدها بعينه خلال الحرب، ليكتب لاحقًا رواية: “لمن تقرع الأجراس”، والتي تحكي عن شاب أمريكي قرَّر المشاركة مع المجموعات الإسبانية المسلحة التي تقاتل لإعلان الجمهورية في مواجهة الفاشية.
يَخلق الرجل لنفسه شيئًا خاصًّا به في الكتابة؛ فهو مراسلٌ حربي ينقل ما يحدث في الواقع كما هو، عن طريق سرد الحكايات التي تجعل من معرفة الحقيقة أمرًا محببًا للقارئ.
يتنقَّل بين جبهات مختلفة خلال الحرب العالمية الثانية، ويشهد حملة الإنزال في نورماندي، وقد بلغ من العمر الرابعة والأربعين عامًا.
(5)
لقد حقَّق إرنست هيمنجواي المولود في 21 يوليو/تموز عام 1899 أمنيته بالسفر إلى الحرب، ليس كجندي مقاتل، ولكن كصحفي حربي وروائي، وسوف تكافئه الأقدار بأن يُشارك في الحربين العالميتين الأولى والثانية، ليستقي من أحداثهما روايات يسردها ببراعة شديدة، وتمنحه شهرة عالمية، فضلاً عن شغفه بتحويل تجارب حياته إلى مادة لمؤلفاته الروائية والقصصية، ومن هنا يمكن تفسير غزارة إنتاجاته.
كان آخر عمل هام نُشر له خلال حياته هو: “الشيخ والبحر” في عام 1952، وهو رواية قصيرة عن صياد كوبي مسن، والتي كانت قصة رمزية تشير إلى كفاح الكاتب نفسه للحفاظ على فنه في مواجهة الشهرة والاهتمام.
أصبح همنغواي شخصية مشهورة غطَّت الصحافة على نطاق واسع زيجاته الأربع، ومغامراته في صيد الطرائد الكبيرة وصيد الأسماك، ولكن على الرغم من شهرته، إلا أنه لم يُنتج عملاً أدبيًّا كبيرًا في العقد الذي سبق ظهور “الشيخ والبحر”؛ حصل الكتاب على جائزة بوليتزر عام 1953، وفاز بجائزة نوبل للآداب عام 1954، وتحول منزله في كوبا التي انتقل إليها إلى متحف يضم مقتنياته.
صحيح أنه نجا من حادثتي تحطم طائرتين في إفريقيا عام 1953، لكنه أصبح قلقًا ومكتئبًا بشكل متزايد، لتكون سنواته الأخيرة هي الأكثر قسوة وصعوبة عليه؛ نتيجة كتلة من التراكمات الضخمة التي ضربت نفسيته، ليقرر الانتحار ويُنهي حياته التي وصفها بأنها صارت بائسة في 2 يوليو 1961، ببندقية في منزله، تمامًا كما فعل والده.