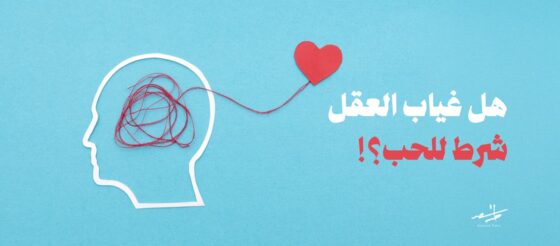(1)
عندما كانت التشيك وسلوفاكيا دولة واحدة تحت اسم “تشيكوسلوفاكيا”، كان هناك شاب اسمه فاكلاف هافل، يكتب مسرحياته المناوئة للنظام الشيوعي، تبدو نصوصه بسيطة لكنها في الحقيقة تفضح عبثية السلطة وظلمها، وبالطبع كان السجن نصيبه، ولأنه عنيد واصل نضاله بعد خروجه من السجن حتى سقطت الشيوعية وليصبح هو رئيسا للبلاد.
تذكرته عندما تذكرت علي، فالرجلان متشابهان، وقد أودت بهما الكتابة إلى السجن، والأثنان خرجا من السجن إلى مقعد الرئاسة، والأثنان يلحّان على الأخلاق في السياسة، ضد ما هو سائد من أن السياسة لا أخلاق لها، وأن المصالح هي الفيصل، والأثنان يؤمنان بالتعدّدية والحريات العامة، مناوئان للشمولية والاستبداد، كلاهما لم يأتِ من خلفية عسكرية أو حزبية، بل من عالم الفكر والكلمة، وقد واجها سؤالًا واحدًا: كيف يمكن للإنسان أن يحافظ على كرامته في وجه سلطة تريد سحقه؟
(2)
هافل كان كاتبًا مسرحيًا يؤمن بأن لا قيمة للكلمة إن لم تقاوم، وبيغوفيتش كان مفكرًا يرى أن الروح هي مركز الإنسان، وأن فقدانها أخطر من فقدان الأرض. كلاهما دخل السجن لا لأنه حمل سلاحًا، بل لأنه حمل فكرة. ومن خلف القضبان نسجا نصوصًا ستصبح لاحقًا خريطة طريق.
هافل كتب قوة المستضعفين، وبيغوفيتش كتب هروبي إلى الحرية. الفارق أن الأول خرج ليقود ثورة سلمية أسقطت الشيوعية في براغ، أما الثاني فخرج ليجد بلاده تتهيأ لحرب إبادة، فصار عليه أن يجمع بين الفيلسوف ورجل الدولة في آن واحد. ورغم اختلاف السياق، فقد اشتركا في قناعة واحدة، وهي أن السياسة بلا قيم تتحول إلى قسوة عمياء، وأن الفكر بلا مسؤولية يصبح مجرد ترف ثقافي.
لكن الاختلاف ربما هو أن هافل كان علمانيًا وجوديًا، بينما بيغوفيتش كان يستمد رؤيته من الإسلام.
(3)
ربما يذكرني علي عزت بيغوفيتش بنيلسون مانديلا، فالسجن عند كلاهما لم يكن مجرد مكان للعقوبة، بل مدرسة للروح وصقل للقيادة. كلاهما قضى سنوات طويلة خلف القضبان، وخرج أكثر قوة وهدوءً مما دخل.
مانديلا تحوّل من ناشط سياسي ملاحَق إلى رمز وطني يختزن حلم شعب بأكمله، وبيغوفيتش خرج من زنزانته برؤية أعمق لدور العدالة والروح في بناء الدولة. التشابه بين الرجلين أن كليهما رفض أن يتحول إلى صورة مشوهة صنعها السجّان، لم يخرجا مكسورين أو متعطشين للانتقام، بل خرجا بقلوب تسعى للمصالحة وبعقول تحاول أن تجد طريقًا للعدل.
مانديلا خرج من السجن ليقود بلاده إلى مصالحة كبرى بعد سقوط الأبارتهايد، حيث كان العالم كله يقف معه، وكانت لحظة التحرر تحمل روح انتصار جماعي. بينما خرج بيغوفيتش ليجد بلاده في مستهل أزمة أدت إلى حرب إبادة، وكان عليه أن يتخذ قرارات يومية بين الدفاع عن شعب يذبح، وبين الحفاظ على مبادئه الإنسانية.
مانديلا استطاع أن يقدم نموذجًا عالميًا للصفح والتسامح، أما بيغوفيتش فقد ظل يذكّر شعبه أن “العدالة أهم من الدولة”، حتى وهو يتفاوض مع من تلطخت أيديهم بالدماء. وإذا كان مانديلا قد أثبت أن التسامح يمكن أن يعيد صياغة وطن، فإن بيغوفيتش أثبت أن القيم يمكن أن تصمد حتى في أشرس الحروب، وأن الحفاظ على إنسانية المرء وسط المجازر قد يكون أصعب من أي انتصار عسكري.
(4)
يذكرني علي عزت بيغوفيتش بمحمد إقبال، الشاعر والفيلسوف الهندي، الذي كتب أشعاره وكأنها نداء للأمة الإسلامية أن تستيقظ من سباتها. وتغنى في قصائده بالروح التي هي سر القوة، وسر الحياة فالإنسان بنظره لا يُقاس بما يملك، بل بما يحلم، وقد ألهمت كلماته تأسيس باكستان فيما بعد.
ثم جاء بيغوفيتش بعده بعقود، وكتب كتابه الأشهر الإسلام بين الشرق والغرب. فيه رسم صورة متوازنة، كأنه يقول إن الإسلام ليس مجرد ماضٍ يُحفظ في المتاحف، ولا مجرد طقوس، بل هو رؤية متكاملة للإنسان والحياة.
كأن بيغوفيتش هو الامتداد العملي لإقبال، أحدهما نفخ الروح بالشعر والفلسفة، والآخر جسّد تلك الروح وهو يقود أمة نحو الاستقلال.
يلتقي علي عزت بيغوفيتش مع محمد إقبال عند نقطة مركزية، فكلاهما رأى أن الإسلام ليس ماضيًا يُحكى، بل مشروعًا للمستقبل. إقبال حمل الهمّ شعراً وفلسفة، يوقظ الروح الشرقية من سباتها، ويزرع في النفوس أن النهضة تبدأ من “خودي” الإنسان، أي من وعيه بذاته وكرامته.
أما بيغوفيتش فقد ترجم الفكرة إلى خطاب فكري متماسك في كتابه الإسلام بين الشرق والغرب، ثم مضى بها إلى ميدان السياسة وهو يقود شعبًا يحارب للبقاء. التشابه بينهما أن كليهما جمع بين الفلسفة والرؤية الروحية، وأنهما خاطبا الإنسان المسلم لا باعتباره تابعًا للتاريخ، بل صانعًا له. لكن الاختلاف أن إقبال ظل في فضاء الحلم والشعر، ملهِمًا من بعيد لميلاد باكستان، بينما وجد بيغوفيتش نفسه في معترك الدولة والحرب، مضطرًا لأن يوازن بين المثال الذي يحلم به والواقع الذي يفرضه الدم والدمار.
(5)
يذكرني علي بآخرين، لكن له فرادته، كتاباته رائعة، صحيح لكن صدقه أكثر روعة، فكثر هم الذين يكتبون، وقليل هم الصادقون، وإذا اقتربت من علي، ستجد له سمتين، الثبات والاستمرار، بما يتوافق مع ما كتبه مرارا من أن التاريخ لا يصنعه الذين يندفعون بسرعة ثم يتوقفون، بل الذين يواصلون الطريق في صمت وإصرار، وأن العظمة الإنسانية ليست في البداية المضيئة، بل في القدرة على الثبات حين تخفت الأضواء، وأن الحرية تحتاج إلى رجال يصبرون أكثر مما تحتاج إلى رجال يثورون، وأن الانتصار لا يُقاس بلحظة حماسية، بل بالقدرة على احتمال الطريق كله حتى النهاية، والأهم أن الطريق إلى الله طويل، والسر ليس في السرعة بل في الاستمرار.
علي ظل ثابتا على ما يعتقد من صغر شبابه إلى أن توفاه الله، معتنقا نفس المبادئ في مساره الحياتي الصعب، واستمر في عطائه لنصرة ما يعتقد، وفي كل الأحوال لم يقدم تنازلا واحدا، كان بسيطا إلى حد أنه أندهش كما ذكر في مذاكراته كيف يمكن أن يزج بالمرء في السجن عقابا على ما كتب، أو على ما يعتقد، وعندما أصبح رئيسا لبلده، احتفظ بفريق عمل فيهم من هو على نقيض أفكاره، ولم يقع ضرر على صاحب رأي خالفه.
لو كتب لك أن تلتقيه لوجدته هو نفسه كما كتب، أمام الكاميرا كما خلفها، فوق مقعد الرئاسة كما كان سجينا، كما كان مواطنا عاديا، نفس المبادئ ونفس الأفكار، لم يخنها أبدا.
بالطبع لم يكن كاملا، كما هي سنة الحياة، فليس هناك على الأرض من ليس به نقص إلا من اختارهم الله رسلا له.
وفيما كان البعض يعتقد أن الفلسفة لا مكان لها في زمن الحرب، فإن تجربة بيغوفيتش أثبتت العكس، أن أعظم السلاح هو أن تبقى إنسانًا حين يريد الآخرون أن يحولوك إلى وحش.
علي يذكرنا بالرجال، ويذكرنا بالمبادئ، ويذكرنا بالثبات والاستمرار، وحين نستعيد ذكرى رحيله، في 17 أكتوبر من كل عام، لا نتذكر فقط رئيسًا بوسنيًا أو قائدًا سياسيًا، بل نتذكر إنسانًا حاول أن يثبت أن الأفكار يمكنها أن تهزم المدافع.