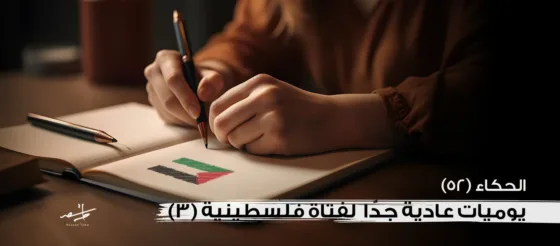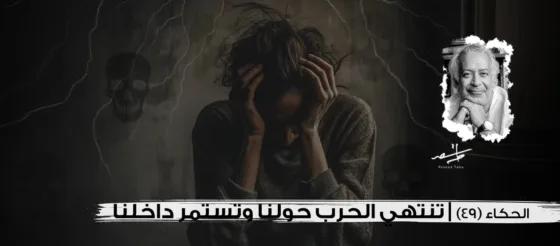الأشد على المرأة من الحرب
(1)
أجلس في أحد الصباحات الباكرة قبل شروق الشمس أمام مكتبي، يتصاعد البخار من كوب الشاي أمامي، فيما أحدق بتفاؤل ساذج في شاشتي، أتهيأ لإعداد محاضرتي المقررة عن بعد لإحدى الجامعات الأمريكية، أظن أن الأمر لن يستغرق وقتًا طويلًا على الإطلاق.
بعد مرور ساعة واحدة أجلس كالصريعة وأنا أنظر إلى شاشة فارغة، أحاول غربلة أفكاري التي استخلصتها من خبراتي في العمل في الصحافة، خصوصًا كفتاة بريطانية من أصل عربي تعمل في منطقة عربية.
(2)
كنت في سيارتي على طريق ترابي طويل مع رتل تابع لإحدى المليشيات من مصراتة الليبية باتجاه سِرْت لإجراء تغطية صحفية حول معاقل داعش آنذاك، أستمع إلى السائق وهو مقاتل سابق يتغنى بأول قتلة ارتكبها، يصف بسعادة تفاصيل ما جرى، صديقتي وزميلتي غير العربية الجالسة في خلف المركبة أحنت رقبتها وقالت “يا آية.. ماذا يقول؟” لم يكن لدي قلب يحتمل إعادة سرد ما قاله هذا الرجل.
ثم فجأة أتذكر بغضب ما جرى في مكان آخر، تحديدا في القاهرة، حين نظر إلي ملازم مصري شاب، طويل الشعر وبشرته داكنة، رمقني حينها بنظرات كلها صلف وغرور، مواصلًا استهزاءه بصورتي على جواز سفري، في حين أنه في نفس اللحظة يندلع قتال مسلح خلفنا، ويحاصَر المسجد الذي بجوارنا.
(3)
حادثتان كان لهما فضل الشرارة التي أطلقت أخيرًا ودون رغبة مني سيلًا من الذكريات، حكايات متناثرة من هنا وهناك، لا علاقة بينها سوى أنها جرت كلها في أوقات ليست سهلة أمضيتها في جنوب السودان وتركيا وتونس ولبنان.
ذكريات متناثرة، ربما أتت لتساعدني في تشكيل محاور محاضرتي، من كيفية تحرك الصحفي في بيئة معادية، إلى كيفية المحافظة على ميثاق الشرف والأخلاق في أثناء التغطية الصحفية، إلى كيفية مواجهة التمييز.
وبرغم استماتتي ومحاولتي، فإنني لم أستطع تحاشي الموضوع الرئيس الذي طُلب مني مناقشته، ألا وهو التحرش، كان قلقي يتنامى ويتسلل إليّ بمجرد الحديث عنه، ينساب بين أصابعي الشعور بالخدر، وأتصبب العرق مع الشعور بالبرد والقشعريرة.
(4)
قمت بسحب مقعدي على عجل، ومراجعة الأسئلة بسرعة في رأسي، أما هو فقد جلس في المكان المحدد قبالتي، كنت على علم بوقته، لم يكن من السهل تأمين هذه المقابلة مع السياسي الليبي الشهير، ألقيت نظرة خاطفة على صديقتي وزميلتي التي سألت عما إذا كان بإمكانها أن تكون موجودة معي خلال المقابلة، بينما أخرجت أنا المفكرة والقلم.
بدأ الحوار، وبدأت أوجه أسئلتي إلى ضيفي، ومع كل سؤال كان يتطلع إلى صديقتي ويجيب، السؤال الأول، فالثاني، وفي الثالث استوقفته، “يا سيد فلان .. هل هناك شيء مع زميلتي؟”، فأجاب: “ماذا تعنين؟ أنا أرد هنا على المراسلة التي بصحبتك”، التفت إليَّ منزعجًا قليلًا كما لو كان يلاحظني للمرة الأولى.
تحجر وجهي وأجبته ببرود بأنني أنا المراسل هنا، أنا الذي رتبت هذه المقابلة، أجاب باللغة العربية هذه المرة: “آه ، لقد ظننت أنكِ المترجم..”، زميلتي وصديقتي النيوزيلندية الشقراء، نظرت إلينا بتساؤل، عندما خرجنا بعد حوالي 30 دقيقة شرحت لها ما حدث، نظرت بعيدًا عني وضحكت ضحكة غير مريحة، يبدو أننا لسنا جددًا على هذه التجربة.
(5)
بعد عامين من مسيرتي المهنية، أجد نفسي أجلس على مائدة العشاء مع أصدقائي في تونس، الشوك والملاعق تتناثر، بينما بدأ أحد أصدقائي يُقنعني بلطف بمقابلة صديق له، “ماذا عن الغداء فقط معه؟.. حسنًا، هل ينفع فنجان من القهوة معه؟”.
فجأة توقف عن التفكير قليلًا ثم تراجع رافضًا: “في الواقع.. لست متأكدًا من أنه سيكون سعيدًا بسفرياتك ورحلاتك، والتواجد في تلك الأماكن التي تذهبين إليها”.
نظرت إليه وفمي مفتوحًا من الصدمة، ولم أستغرب ما قاله، لقد سمعت ذلك من قبل، دائمًا تتركني المعايير المزدوجة في حيرة من أمري، إنها تؤرقني لأنها غير مفهومة، فقد كان هو وصديقه صحفيين أيضًا، ومع ذلك فإن ما هو مقبول عندهما في العمل غير مقبول في شريك الحياة الذي يحلمون به.
(6)
لقد كانت رائحة الطعمية الزاكية تفوح من خلال الهواء القاهري اللزج الدافئ، الذي جعلها باقية لفترة أطول، كنت أبحث عن المصوِّر ومهندس الصوت، واجتذبتني الرائحة إليهما، وجدتهما – وقد جلسا في “جراج” وكأنهما مذنبين – بمبنى مكتبنا متأخرين عن العمل، كانا يأكلان الطعمية المغموسة في الطحينة والخضروات المخللة.
نظرت إليهما وقد خاب أملي، ثم استسلمت، لقد مرت بضعة أشهر حتى الآن في وظيفتي الجديدة كمراسلة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مصر، وكنت أعاني من صدام ثقافي لم أتوقعه، من بينها استشعاري لمعنى أهمية الوقت حسب المنطق البريطاني ومعنى الوقت بالمنطق المصري، خمّن أيهما له الغلبة؟
نظر كلا الرجلين لي وهما يشعران بالذنب، ودون أن ينبس أحدهما ببنت شفة، مدا أيديهما بسندويتش إضافي، مشيت على مضض، وأمسكت به، وانضممت للجمع.
ثم بمرور الوقت صار هذا تقليدًا ضمنيًّا لنا مع جميع أفراد الطاقم وكلهم من الرجال، نتناول الإفطار معا وببطء، ولكن بالطبع بعد أن وثقوا بي، وتم قبولي واحدة منهم.
في عدد من أسوأ المواقف في مصر، كان هؤلاء الرجال هم الذين اعتنوا بي وحموني بأقصى طاقاتهم من الأذى الجسدي، لم يكونوا بحاجة إلى القيام بذلك، ولذا أذكر لهم ذلك جيدا.
(7)
كان آخر يوم لنا في مصراتة، وكنا نسارع في محاولة للفوز بأكبر عدد من المقابلات الصحفية الممكنة، ومع اقتراب نهاية اليوم شعرنا بأنه ليس لدينا خيار سوى أن نفترق، هرعت إلى السيارة المنتظرة إلى جانب الفندق، وحقيبتي تتأرجح بجنون على جانبي ودفتري في يدي، أقفز دون تفكير إلى مقعد الراكب الأمامي للسيارة، يستقبلني السائق الشاب مسرورًا، لقد أمضى ما يقرب من أسبوع يقود جولاتنا في جميع أرجاء المدينة، وقد شعر بأنه مرتاح معنا، فتحت دفتر ملاحظاتي الصغير وغرقت فيه بسرعة استعدادا للمقابلات المتتالية.
خيم المساء بسرعة علينا، سألني “هل أنت متزوجة يا آية؟” فرددت متمتمة على مضض “لا” فبادرني قائلًا: “هل يمكننا البقاء على اتصال؟” أغمضت عيني لفترة وجيزة وفهمت ما سيحدث، فقلت: “أنا لست متزوجة، ولكن مرتبطة بشخص آخر”، إنها إجابة تلقائية كنت أتعلمها منذ الجامعة قبل التوجه إلى سوريا.
جحظت عينا السائق الشاب فجأة، واتسعت أنفه، وصرخ فيّ “أنتِ تكذبين!” فاستدرت وأنا مصدومة من تحول موقفه ونبرته من الهدوء والبهجة إلى الغضب العارم، قفزت عيناه بشكل محموم إلى الدرج الموجود في لوحة القيادة، وكنت أعلم أنه يحتفظ ببندقية، ثم قال بعصبية: “أنتِ لا تحبينني على الإطلاق، قوليها”.
خفت حتى بات قلبي على وشْك أن يقفز من صدري، لكن صوتي لم يهتز عندما أجبت بهدوء: “من فضلك توقف هنا على جانب الطريق، سأمشي بقية الطريق”، نظر إلي والغضب يملأ وجهه، وكررت بهدوء: “إذا لم تفعل فسأبلغ الرجل الذي اختارك لنا”، وكان من أقصده مقاتلًا سابقًا وشخصًا يحظى بالاحترام في محيطه، فما كان عليه إلا أن صف السيارة على جانب الطريق عند إشارة المرور، فتحت الباب بهدوء وخرجت، انطلق بعدها كالصاروخ، وقفت على جانب الطريق، ولأتمالك نفسي وأهدأ استدعيت إلى ذاكرتي جميع محطات مترو الأنفاق في خطوط “باكرلو” في لندن التي اعتدت ركوبها ووقفت أحصيها محطة بعد محطة حتى أستطيع التقاط أنفاسي قبل ان أدخل المقابلة التالية.
(8)
لقد غطيت أعمال شغب مسلح، وسافرت إلى معاقل داعش، وقمت بتغطية الحرب الأهلية في جنوب السودان، لكن إذا سألتني عن المكان الذي شعرت فيه بأقصى درجة من انعدام الأمان كامرأة لقلت: في مصر، بلد أبويّ، والبلد الذي أتوارث جيناته.
كنت أستعد لتغطية أول احتجاج لي في مصر، فهي الذكرى الأولى للثورة، وكان من المتوقع أن تكون احتجاجات معتدلة، هاتفي كان مفتوحًا على السماعة الخارجية، صديقة من الذين انضموا إلينا لم تكن لتفعل شيئًا سوى الصراخ بالتعليمات: “… يا آية ارتدي ملابس السباحة تحت ملابسك”، أتوقف مشدوهة! “ارتدي ملابس السباحة؟! هذا شيء غير مريح على الإطلاق، ما هذا؟”، ثم أردفت قائلة: “إذا تعرضتِ للتحرش وتمزقت ملابسك، فسيواجهون صعوبة في الوصول إلى جسدك كاملًا”، قالت جملتها بعفوية وعملية في آن واحد، وما حدث بالفعل أنني تعرضت للتحرش.
(9)
كونك امرأة في مصر أمر مرهق، إنه أشبه بممارسة رقصة بهلوانية، من اللحظة التي ترفعين فيها رأسك عن الوسادة وحتى تضعيها مرة أخرى، أقضي الصباح في الحيرة المعتادة، أخطط لما أرتديه اليوم، يجب أن يكون زيًّا فضفاضًا بما فيه الكفاية، وأقل جاذبية، وألا يكون لافتًا ، أليس كذلك؟.
وبعد قضاء بعض الوقت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سأقوم بتكوين خزانة ملابس مختصة بمقاومة التحرش في هذه المنطقة، وحين أغادر منزلي علي أن أتأكد أن الطريق الذي أسلكه سيكون أقل الطرق احتمالية للتعرض للتحرش، وفي رحلتي إلى مكان عملي علي التعامل مع التعليقات السخيفة العدائية على مضض.
مع الوقت بدأت أتغير، الطريقة التي أتحدث بها، والطريقة التي أمشي بها، وطريقة ارتدائي لملابسي، إن هذا الشيء يقويني بطريقة لم أكن أضعها من قبل في الحسبان.
من الدروس التي تعلمتها من النساء المصريات عنادهن وإصرارهن على الكفاح من أجل أنفسهن وما يردن، بغضِّ النظر عن بيئتهن الاجتماعية، بغضِّ النظر عما قيل لهن، وبغض النظر عما قد يحدث لهن، لكن ذلك جعلني أدرك بشكل مؤلم حقيقة أنه في حالتي إذا اخترت أن أبقى في المنطقة فأنا حرة، ويمكنني المغادرة متى أردت، وأخذ قسط من الراحة متى أردت، ثم أعود مجددًا أكثر عزمًا وتصميمًا، لقد كان ذلك امتيازًا غير عادل.
بعد سنوات، جاءت مجموعة من الأصدقاء المصريين لزيارتي في لبنان، حيث كنت أعمل في ذلك الوقت، وبينما كنا نسير على طول الساحل، سأل صديقي بصوت عالٍ صديقاتنا لماذا لا ترتدي المرأة المصرية ملابسها أو تعتني بنفسها مثل النسوة اللبنانيات؟! انفجرن جميعًا بالضحك، وملأن الكون قهقهات على جهله، ثم أطلت إحدى الصديقات في النهاية تخبره وهي تلتقط أنفاسها قائلةً: “سنفعل إذا كان بمقدور مصر أن تقبلنا!”.
(10)
هذه ما قصته ابنتي عليَّ حين طلبت منها أن تحكي لي شذرات من تجربتها الصحفية في المنطقة العربية، كنت أظن أنني أعرف كل حكاياتها إلى أن استمعت إلى ما قرأتموه.