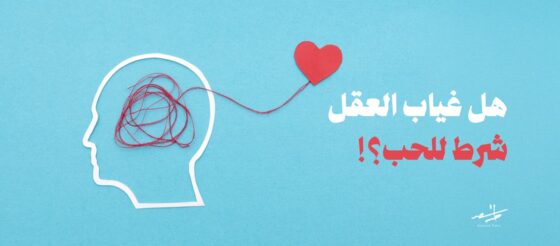ما أن أنجبتني أمي بدقائق إلا ونادت أختي الكبرى إلى سريرها وأجلستها القرفصاء، أخبرتها أنها أتت لها بهدية، وضعتني بصراخي في “حجرها”، وقالت لها: أنت من الآن أمّه الصغرى، كانت والدتي -رحمها الله- تنشد أن تجنب ابنتها بسنواتها العشر الغيرة من قدوم جديد يستأثر بالاهتمام، غير أن أختي لم تعترف بذلك، مضت في حياتها كلها تؤدي بإصرار مهمة الأم الصغرى، حتى بعد أن بلغت السبعين من العمر.
هناك بعض الروايات تنقلك إلى عالم آخر، تهزك بشدة، تثير أفكارك وأشجانك، تمتعك في كل لحظة، لكن المشكلة تقع عندما تشعر أن الرواية تقترب من النهاية، فإن الخوف يسيطر عليك، أنت لا تريد لهذه المتعة أن تنتهي، لا ترغب لهذه الرحلة أن تتوقف، وقد قضيت معها وقتاً جميلاً.
لكن ما شأننا بذلك الآن؟
حسناً.. لقد راودتني الخاطرة!
انبرت إذاً تمارس مهمتها بجدية شديدة، هي تكبر وأنا أكبر، تعتني بي، تناقشني، تنصت باهتمام شديد لحكاياتي وآرائي السخيفة، تختلف معي، تعبّر عن ذلك بصراحة، لكنها لا تملّ، ولا تغيّر رأيها أو موقفها، تزودني بالقروش لأشتري كتباً لا تؤمن بها، وتقنع والديّ بالاستجابة إلى طلباتي حتى وإن لم ترُق لها، إنها معي دائماً، هكذا الأمر ببساطة، إنها الأم الصغرى، ولا يحق لها سوى ذلك.
ما يجري مع الرواية المكتوبة، يجري مع الفيلم المشاهد، إذا ما راق لك وحرَّك سواكنك، عِشته بكل جوارحك، فإذا ما جاءت نذر النهاية انتابك القلق، خذ مثلاً فيلم عمر المختار، فعندما أُعدم البطل الذي قال: نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت، كنا ندرك نحن معشر المشاهدين أن الفيلم الذي هزَّنا هزاً قد بات على وشك النهاية، وأن دقائق معدودة وستنتهي مُتعتنا، وستسكن سواكنا التي حرَّكها الفيلم، فنتمنى لو يطول قليلاً.
بالمناسبة كانت أختي في ليبيا حين أتى أنطوني كوين لتصوير الفيلم العظيم، تحكي لي أن الرجل كان يرتدي اللباس الليبي التقليدي، وينزل إلى الشارع، يختلط مع الناس ويتكلم معهم، ويعيش تفاصيل حياتهم، رغبة في محاكاتهم، حتى يتقنَ الدور تماماً.
في الصيف كانت تعود في عطلتها إلى بيتها، أكاد كل مساء أترك بيتنا وأذهب إليها، حول أطباق أصابع البطاطس المحمرة، وأكواب الشاي بالنعناع، والتليفزيون الذي لا ينتبه إليه أحد تكون أمسياتنا، زوجها وأولادها يدركون قواعد اللعبة جيداً، ويتعاملون مع حضورنا على أنهم هم الغياب، فإذا ما شعروا أن حديثنا بات هامساً انسحبوا حتى لا تُفشى الأسرار.
لم أكن حاضراً في هذا المشهد، لكنني أضحك بشدة عندما كانت تقصّه عليّ، فقد دخلت يوماً على والدي الرجل المتدين، وهو جالس في الشرفة مع والدتي؛ لتقول له: أين الله؟ مَن قال إن الله موجود؟ لماذا نحن مسلمون؟ من زعم أننا على حق، احمرَّ وجه أمي، واعتقدت أن الوالد سيخرج عن طوره رغم ما عرف عنه من هدوء الطباع، التفت إلى أختي وقال لها ببساطة شديدة “طيب اقعدي بس نتكلم”، ثم استدار إلى أمي قائلاً: “ما تعملي لنا قهوة يا أنيسة”.
لاحقاً كانت أختي أول محجبة في كليّتها القاهرية، في وقت لم يكن يضع غطاء الرأس إلا العجائز أو الخادمات، جلسات الشرفة في طابقنا التاسع بالسويس أثمرت نتائج عقائدية وإنسانية، وبات ارتباطها بأبي غير ارتباطها بأمي، نفس قوة الشعور مع اختلاف في الزاوية والمذاق، وفي كلٍّ خير.
مرة وعندما حان موعد عودتها من عطلتها رشحتني العائلة لمهمة مؤلمة باعتبار قربي منها، وهي إبلاغها بوفاة والدي بعد أن أخفينا الخبر عنها شهرين، انهارت تماماً، أبلغتها أنه ضرب لنا موعداً في الجنة.
نحن نبكي ونحن نقرأ نهاية الرواية أو نشاهد نهاية الفيلم، نبكي للفرح ونبكي للحزن، السبب الأخير هو الأغلب، نبكي رغم أننا لسنا معنيين بالأمر، بل زد على ذلك نحن موقنون أن هذه الشخصيات والأحداث وهمية، لكنها تلامس شيئاً داخلنا، ظاهرنا أننا نبكي لها، والحقيقة أننا نبكي لأنفسنا.
عندما ألجأ إليها فإن الحد الأدنى المتحقق هو “الفضفضة”، هذا إن اختلفنا في كل الاستشارات التي تقدمها لي، مع أخي صاحب الأفضال كانت حاضرة دائماً في كل أحداثي التعيسة والسعيدة، في المشافي والمعتقلات والكليات، وفي كل الأفكار الجنونية التي عادة ما أتبنَّاها.
بعد أن تمر السنون تنظر إلى ما كان يمر بك وكنت حينها تعتبره أمراً عادياً، فترى أنه كان أمراً عظيماً، ليته يعود مرة أخرى، لمّة العائلة، أفراحها، أتراحها، حتى مشاجراتها، وتنتابك رغبة جارفة أن تعيد الشريط من أوله بعد أن أدركت قيمة ما جرى، لكن هيهات هيهات؛ لذا يتلبَّسك القلق من أن ينتهي الشريط الدائر الآن فجأة.
كنت في القاهرة، حين أبلغت بخبر تعرضّها لوعكة صحية قاسية، أصابني الجنون، خِفت أن يكون ذلك نذر النهاية، يا ربي كيف تستقيم الحياة إذا ما وقعت الواقعة، أنا خبير بهذا النوع من الوجع، إنه لا ينتهي، ولا يلتئم، إنه يكبر، تظن للحظة أنك تجاوزته، ثم تنفجر باكياً كما كنت هذا الصغير في “حجرها”، هي تعافت وأنا اطمأننت.
يرحم الله أمي، كانت تنظر في عيني فتفهم حالي وكل ما يدور بداخلي، أختي ورثت ذلك وأكثر، فهي ترسل لي -وأنا بعيد عنها آلاف الأميال- رسالة هاتفية في الصباح: “أظن أنك لست على ما يرام اليوم، ما بك؟”، أحتار، هل أكون صادقاً وأحدثها عن السبب فتحزن؟ أم أخفي عنها الأمر؟ لكن قبل هذا وذاك كيف عرفت بحالي؟
لكن فَلأعترف أنها لطالما أوقعتني في حرج، حين تزورنا يلتف حولها أولادي تحكي لهم ما كنت أرتكبه صغيراً، أمور نسيتها تماماً واندثرت من الذاكرة، تندهش كيف هي تتذكرها وتحفظ تفاصيلها، وصغاري الشياطين يلتفون حولها ويطالبونها بالمزيد، إنها أوراق رابحة في أي مجادلات بيني وبينهم، يظلون يذكرونني بها تكراراً ومراراً.
كأمر القميص الذي رفضت ارتداءه صباحاً؛ لأنه (بايت)، وتشاجرت مع أمي وطالبت بقميص طازج، وكأمر الرسائل التي كنت أبعث بها وأنا ابن الرابعة أو الخامسة إلى الكلب الصغير الذي كان يقتنيه صاحب محل أمام بيتنا عندما سكنا بورسعيد، كنت أمسك بالقلم وأرسم خطوطاً وأرمي بالقصاصات إليه، مرة كدت أن أقفز من الشرفة في الطابق الأول لمعاقبة هذا الكلب الذي لا يرد على رسائلي، هي تحكي وأولادي يطالبونها بالمزيد.
آه.. ليس أجمل من أن تكون لك صديقة وأخت وأم في آن واحد، تسبقك بخطوة، وتمسك بيدك حتى تعبر ما تمر به، والحياة عاصفة تهدأ أحياناً وتثور كثيراً، وهي في ذلك كله تحملك على الصبر، وتبشرك بالخير القادم، تؤكد لك بكل جوارحها أن فرج الله آتٍ لا محالة، كأنها نظرت فرأته، تتحدث بيقين عجيب، تحسن الظن بالله، وتستشهد بالآية والحديث، وفي كل الأحوال لا تتخلى عنك أبداً.
لكن فجأة يبدو أنها فعلت، كان ذلك قبل يومين، الأربعاء الرابع من يناير/كانون الثاني عام 2017، حين جاءني اتصال يبلغني بصورة قاطعة أنني بتُّ وحدي في العراء، لا حائط يحميني، ولا ظل يقيني، ولا قلب أتكئ عليه، ثم أُبلغت بصورة حاسمة: “لقد تركَت مهمتها ولم تكلف بها أحداً”.
أعرف منذ زمن بعيد أن البقاء لله، لكن هأنذا أعرف من جديد أن “السند” لا بقاء له.
يا ويلي!